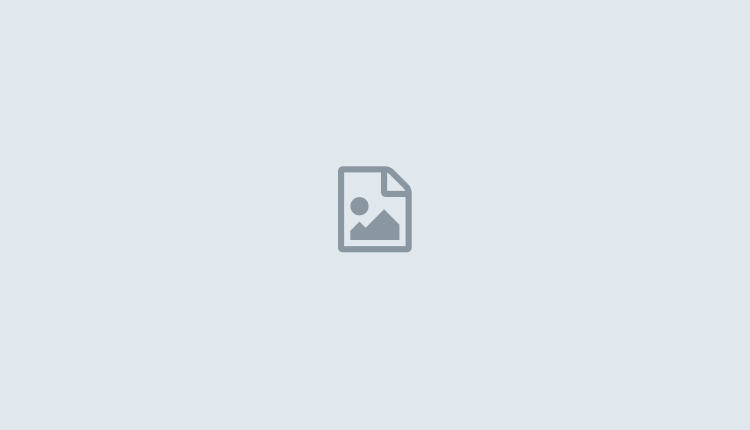حين تحرد جالاتيا من بجماليون!
في الميتولوجيا الإغريقية والرومانية، كان هناك رجل يسمى «بجماليون» يعمل نحّاتا عظيما يكره النساء، فصنع تمثالا من العاج على هيئة امرأة جميلة جدا، وضع فيها كل ما يحب من صفات في المرأة، لشدة ولعه بحبها.
وبدأ كل يوم يزينها بالملابس الغالية واللؤلؤ، وأخيرا في عيد آلهة الحب «فينوس» رجاها أن تحيي التمثال، فأحيته ودبت فيه الحياة، وسمى التمثال الحي «جالاتيا» ثم تزوَّجها، فولدت لهما بنتا أسمياها «بافوس»، أسست مدينة «بافوس» في قبرص، وثمة اختلاف في الروايات حول نهاية القصة، فمن قائل إن «جالاتيا» خانته وهربت مع رجل آخر، ومن قائل انه ملَّها، بعد ان تحولت إلى امرأة عادية، تكنس وتنظف وتطبخ، حيث سأل آلهة الحب أن تعيدها إلى سيرتها الأولى، كتمثال، ثم اشتاق لها، فسأل الآلهة أن تحييها، ثم …!
كتب كثير من الأدباء عن حكاية «بجماليون»، كما أنها ألهمت الكثير من الفنانين، ومن أشهر الأعمال الأدبية التي تناولت «بجماليون»: مسرح «بجماليون» لجورج برنارد شو (ثم حوَّلها الأمريكيون لفيلم «سيدتي الجميلة»). في هذا المسرح «بجماليون» هو الأستاذ هنري هيجينز الذي يجعل من امرأة فقيرة جاهلة سيدة محترمة في أعلى طبقات المجتمع بتغيير لهجتها وثقافتها ولبسها، أما مسرحية «بجماليون» لتوفيق الحكيم، فهي مسرحية فكرية تدور حول الصراع بين «الحياة» و»الفن»، من أجواء مسرحية الحكيم، أقتبس ما يلخص المشهد كله..
فينوس : ما رأيك يا أبولون لو نفخنا الحياة في تمثاله هذا مرة أخرى، وأعدنا إليه زوجته من جديد؟
أبولون : أتدرين ما الذي يحدث لو فعلنا ذلك ؟
فينوس : ماذا ؟
أبولون : عين ما حدث في المرة الأولى .. يقبل على «جالاتيا» الحية معجبًا فى بادئ الأمر..ثم لا يلبث أن يراها أقل جمالا و كمالا من «جالاتيا» العاجية .. فيطالبنا بردها كما كانت، صائحا في وجوهنا بعين الألفاظ المهينة .. فإذا أعدنا إليه عمله الفني، هدأ لحظة ثم عاد يراه أقل جمالا و كمالا من الصورة الحية .. وهكذا دواليك ..لن يقر له قرار , ولن يطمئن له بال ..فلا جمال الحياة يشبعه، ولا جمال الفن يكفيه .. ولن يفتر عن ملاحقة الجمال والكمال في شتى الصور والأوضاع ومختلف الأشكال والأحوال ..لا ينطفئ له ظمأ إلا بانطفاء الشعاع الأخير من نفسه القلقة الحائرة!
-2-
بجماليون.. الخارج من سديم الاعتياديّ/ المختنق بدخان الأنوثة/ المفجوع بالعاطفة/ المطعون بخاصرة الشّغف/ المتأزّم بشهيّة الجمال/ يقف على صمم العاج متكئاً على هبوب الرؤى ورائحة الأنوثة المتحدّرة من عناقيد عرائس الجنّة، ومن أنوار وتجلّيات حلم انتظره منذ الأزل/ ما بين أصابعه والعاج مسافة الجنون/ مسافة الحنين/ مسافة الرّنين/ الضّوء في عينيه مجرّة/ وفي أصابعه لمسة خرافية/ وفي رؤاه دراية المبدع واهب الزوايا والخفايا وانحناءات الصدى/ حين يذهب في الرّنين/ لتشرئبّ جالاتيا/ حورية بأوج فصولها وعصورها وطيورها/ وفيض أقمارها وأنهارها وسنابلها وزفرات الرّيح/ فكرة تتجسّد بأبعاد حسّية وفنيّة وعشقيّة/ كان مختنقاً بالنساء ليتنفس هذا الكائن الذي صوّره على مقاس تصوراته ورؤاه/ كان ينحت فيها الجمال فأضاءت، وما من أنثى معتمة إلا وكانت جريرة فشل مبدعها!
-3-
في تحديث جديد للأسطورة، تستمرئ جالاتيا «الحرد» من «بجماليون»، أملا في «استخراج» مزيد من المودة والحرص، أو لاختبار مدى معزتها، ومدى ما يختزنه قلبه من محبة، ولكن
حينما تصبح «الحردنة» نهجا مستمرا، أو طريقة «بائسة» لعمل «رفرش» للعلاقة الثنائية أو إعادة تنشيط، تفقد المسألة بهجتها، وتتحول إلى نوع من عبث سيزيف مع صخرته اللعينة، التي ما أن يصل بها إلى أعلى الجبل، حتى تدحرجها الآلهة إلى القاع، ليبدأ برفعها من جديد، وفق الأسطورة اليونانية أيضا!