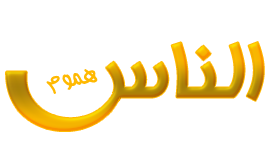د. علي اشتيان المدادحه يكتب .. أثر الخطط الوطنية التنموية على الدين العام
الدكتور علي اشتيان المدادحه يكتب تعقيبا على تقرير المنتدى الاقتصادي الاردني بعنوان: ” أثر الخطط الوطنية التنموية على الدين العام “
بداية كل الشكر والتقدير والعرفان على هذا التقرير المميز من قبل المنتدى الاقتصادي الاردني , الذي شخص الواقع الاقتصادي الأردني من خلال قراءات في التجارب السابقة وفرص رؤية التحديث الاقتصادي .
فقد أشار التقرير في نهاية الملخص التنفيذي ” أن الرؤية الوطنية , مهما بلغت طموحاتها , لن تنجح في خفض المديونية الا اذا جعلت من كل دينار مقترض رأسمالا يولد النمو لا عبئا يستهلكه : فاستدامة الدين في الأردن تبدأ من كفاءة ادارة المال العام , لا من حجم الاقتراض ذاته ” انتهى الاقتباس ”
وفي مقدمة التقرير أشار ” ومنذ نشأة الدولة الأردنية ” , توالت خطط وطنية تنموية طموحة استهدفت تحقيق نمو شامل وتحسين رفاهة المواطنين . وصولا الى رؤية التحديث الاقتصادي الراهنة .
الا أن هذه الرؤيا واجهت معضلة رئيسية تمثلت في محدودية الموارد المحلية . مما جعل الدين العام الخيار التمويلي الأسرع لتمويل مشاريعها المطروحة . وهنا يبرز سؤال جوهري : هل أسهمت هذه الخطط في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الدين وتحويله أداة استثمارية طويلة الأمد ؟
أم أنها كرست الاعتماد على الاقتراض دون أن ترافقه عوائد انتاجية كافية تخفض نسبة الدين الى الناتج ؟ انتهي الاقتباس
وحسب خبرتي العملية بهذا الشأن يلاحظ ان كل الخطط الإقتصادية في الأردن منذ الخطة الإقتصادية الأولى 1973- 1975 وحتى رؤيا التحديث الإقتصادي 2022-2030 أعتمدت في تمويلها على الدين العام ، وايضاً كل الخطط الإقتصادية منذ عام 1980-1985 الثالثة وحتى رؤيا التحديث الإقتصادي الحالية اعتمدت على الإقتراض دون ان ترافقه عوائد انتاجية كافية تخفيض نسبة الدين الى الناتج ، عدا الخطة الثلاثية أعلاه والخطة الثانية 1976-1980 اعتمدت الإقتراض من اجل تحقيق نمو في الناتج المحلي أعلى من فوائد الدين العام ، وكما نبين ذلك لاحقاً .
وبين التقرير واقع الدين العام العالمي والذي يواجه مستويات مرتفعة وغير مسبوقة من الدين العام وسط ضبابية اقتصادية وتقلبات جيوسياسية وتوترات تجارية رفعت نفقات الحكومات وأضعفت استقرار المالية العامة , فقد بلـــــغ الدين العـــــام العالمـــي نحــــو ( 3, 92 % ) من الناتج المحلي الاجمالي , بنهاهية عام 2024 مع توقعات بلوغـــــــه قــرابة ( 95 % ) في 2025 وربمــا ( 100 %) بحلول عام 2030 وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الضبابية في السياسات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية قد يرفع الدين العالمي الى مسار أكثر خطورة , حيث تشير السيناريوهات الشــديدة الــــــى امكانية وصـــوله الـــــى ( 117 % ) من الناتج العالمي , وهو مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية .
2 / 5
أرى ان واقع الدين العام العالمي سببه الرئيسي والأساسي التخلي عن نظام بريتون وودز ونظام اسعار الصرف الثابتة كان يعني فقدان الأنضباط المالي الدولي ، فقد فتح امام التوسع الكبير في الديون الخاصة والقومية والدولية التي حدثت في اواخر سبعينيات واوائل ثمانينيات القرن العشرين وحتى هذه الأيام .
وقد بين التقريرالعلاقة بين النمو الاقتصادي والدين من خلال تركيز الخطط التنموية الفعالة على شقين متكاملين هما , رفع النمو المحتمل عبر الاستثمار في البنية التحتية , التعليم الابتكار , وتحفيز القطاع الخاص , بما يؤدي الى توسيع القاعدة الضريبية وايرادات دائمة . والثاني تحسين شروط التمويل عبر تمديد آجال الاستحقاق , تنوع أدوات الاقتراض , وجذب قروض ميسرة لتخفيض متوسط الفائدة الفعلية , بعبارة أخرى نسبة المنحة في القرض لصالح الدولة المقترضة
وقد بين التقرير أن هنالك مدرستان تحفز النموالاقتصادي هما : – الأولـــــى النمـــو المــــدفوع بالدين (Debt – Led Growth) وهو توجه يرى أن الدين الحكومي قد يكون محفزا للنمو اذا وجه بكفاءة نحو مشاريع انتاجية ذات عائد اجتماعي واقتصادي أعلى من كلفة الاقتراض . وان نجاح هذا المسار مشروط بجودة اختيار المشاريع وفعالية ادارتها
( (” PIMA” Public Investment Management Assessment اذ ان ضعف الحوكمة والهدر يفقد الدين أي أثر محفز . والثاني , الدين التابع للنمو Growth – Led Debt) ) وفق هذه المدرسة , يعتبر النمو المستدام والمتنوع هو القاعدة الصلبة لجعل الدين قابلا للادارة .
وقد أشارت الورقة البحثية الى تجارب عديدة لدول ناشئة واجهت تحديات مرتبطة بتأثير الخطط التنموية على الدين , أبرزها المغرب , حيث اعتمدت المغرب مقاربة مدرسة Growth – Led Debt) ) في حين تبنت تشيلي ما يعرف ب قاعدة الرصد الهيكلــــــــــــــي Structural Fiscal Surplus Rule) ) وهي آلية تجعل حجم الانفاق الحكومي مرتبطا بمؤشرات موضوعية أهمها الناتج الاقتصادي , بدل الاعتماد على ايرادات آنية قد تتأثر بتقلب أسعار السلع . وأن هذه السياسة أدت الى تقليل تقلبات الموازنة ومنحت الحكومة مساحة لتمويل استثمارات عالية الجودة في البنية التحتية والتعليم والصحة , وفي الوقت نفسه حافظت على مستويات الدين في نطاق يمكن التحكم فيه . في حين مثلت الأرجنتين مثالا معاكسا لحالات النجاح , اذ راكمت الحكومة دينا خارجيا مرتفعا بالدولار لتمويل عجز الموازنة والنفقات الجارية بدل الاستثمار المنتج , في بيئة يغلبها ضعف النمو وعدم الاستقرار المؤسسي , مما جعل الدين يتفاقم بسرعة مقارنة بالناتج , وفقدت الدولة القدرة على خدمة التزاماتها بشكل مستدام , مما اضطرها الى اعادة هيكلة الدين العام عام 2020 .
في حين شهد واقع الدين العام في الأردن خلال العقدين الماضيين تراكما تدريجيا في حجم الدين العام . وكما نرى ” ليست في العقدين الماضيين بل منذ منتصف العقد الثامن من القرن الماضي وحتى ايامنا هذه وكما نبين ذلك لاحقاً “. نتيجة تفاعل عوامل داخلية هيكلية مع صدمات خارجية متكررة أثرت في مسار الاقتصاد الوطني . فمن جهة أخرى , أدى انقطاع الغاز المصري الى ارتفاع كلف توليد الطاقة , واغلاق الحدود مع سوريا والعراق الى تراجع الصادرات وحركة التجارة , كما فرض تدفق اللاجئين أعباء اضافية على الموازنة العامة وزاد الانفاق على الخدمات والبنية التحتية , ثم جاءت جائحة كوفد – 19 لتفاقم العجز المالي من خلال ارتفاع النفقات الطارئة وتراجع الايرادات الضريبية , ونتيجة لذلك , تراكم الدين العام بوتيرة متسارعة . واضيف على ما ذكر أعلاه من زيادة تراكم الدين العام من استمرار الاختلال الهيكلي بين
3 / 5
الايرادات والانفاق الحكومي . فقد بلغ اجمالي الانفاق الحكومي حتى نهاية شهر آب من هذا العام نحو ( 41 , 9 ) مليار دينار , توزعت على نفقات جارية بقيمة ( 7 ,8 ) مليار دينار مقابل انفاق رأسمالي متواضع بلغ ( 1 , 753 ) مليون دينار فقط ( أقل من 10 % من اجمالي الانفاق ) ويعكس ذلك أن الجزء الأكبر من الموارد العامة يوجه لتغطية التزامات آنية مثل الرواتب , الدعم .. الخ في حين يظل الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية محدود نسبيا , فحالنا هذا مشابه الى حد كبير حال الأرجنتين المشار اليه أعلاه .
وبعد استعراض العلاقة بين النمو والدين العام , يكمن السؤال الأهم , هل الاقتراض وحده يكفي لتحفيز النمو أم أن العائد يتوقف على كفاءة الاستثمار ؟ .
كما اشار التقرير ومنها ( ( Debt – Led Growth التي تفترض أن الدين قد يولد نموا اذا وجه لمشاريع انتاجية , تعتمد بقوة على جودة ادارة الاستثمار العام . فالمشاريع التنموية ليست متساوية في أثرها الاقتصادي اذ تختلف قدرتها على رفع الانتاجية وتوليد الايرادات المستقبلية . وأن ضعف حوكمة الاستثمار قد يؤدي الى فقدان ما يقرب ( 30 % ) من المنافع الاقتصادية المتوقعة بسبب اختيار مشاريع غير ذات أولوية , أو تضخم الكلفة أو المدة , أو ضعف التشغيل والصيانة لا حقا . لذلك قد ينتهي التمويل بالدين الى زيادة الأعباء دون نمو حقيقي , فتتسع الفجوة بين سعر الفائدة والنمو ( r>j) بدل تقليصها .
ولقياس هذه الكفاءة , طور الصندوق أداة
(Public Investment Management Assessment ( (” PIMA” التي تظهر أن البلدان التي حسنت دورة الاستثمار ( تخطيط , اختيار , تنفيذ , متابعة ) حققت مضاعف استثماري أعلى بمرتين تقريبا مقارنة بالدول التي توسعت في الانفاق دون اصلاح مؤسسي , وتظهر نتائج دراسة البنك الدولي حول استدامة الدين في الأسواق الناشئة أثر على زيادة الانفاق الرأسمالي دون اصلاح المؤسسات المالية غالبا ما يقود الى ارتفاع نسب الدين / الناتج بدلا من تراجعها . بهذا تصبح كفائة الاستثمار هي الحلقة المفقودة بين الدين والنمو .
لذا على كافة اطياف الدولة الأردنية ، حكومة وأفراد ، وجماعات ، الطلب من الحكومة اليوم قبل الغد بأن تتخذ الإجراءات التنفيذية وبعد انحصار معظم العوامل الداخلية والصدمات الخارجية السالف ذكرها والتي أثرت على مسار الاقتصاد الوطني , أن تحفز النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة نسبيا من خلال تهيئة البيئة الملائمة الى رفع كفاءة الاستثمار .حيث يعتبر الاستثمار العامود الفقري للنمو والتنمية الشاملة من خلال رفع معدلات النمو في الناتج المحلي المولد الى الطلب المتزايد على عوامل الانتاج وبالاخص العمالة وبالتالي الحد من نسب البطالة والفقر في البلاد . من خلال العمل بالمسارين التاليين , الأول تحسن دورة الاستثمار ( تخطيط , اختيار , تنفيذ , متابعة ) . والثاني , الاصلاح المؤسس من خلال اعادة هيكلة مؤسسات الحكومة.
وقد انتهجت الحكومة الأردنية في المسار الأول لتحسين كفاءة الاستثمار من خلال الخطط الاقتصادية الأولى 1973 -1975 والثانية 1976 – 1980 . لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وفي كافة القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز وتنشيط الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص . وكانت شمولية ويتم متابعتها من قبل المجلس القومي للتخطيط مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المخطط مع الفعلي , لمعرفة أسباب الانحرافات سواء كانت ايجابية أو سلبية من أجل تعظيم الايجابيات والحد من السلبيات وطرق علاجها . فقد
4 / 5
حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو فاقت توقعات الخطط في معظم القطاعات الاقتصادية , وقد تمثلت هذه الانجازات في تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يزيد من معدل النمو المستهدف في الخطتين , وبناء قاعدة عريضة من البنية التحتية للعملية الانتاجية , وانشاء العديد من الصناعات التحويلية ومشاريع الري والزراعة , وكذلك تم توسيع وتطوير قاعدة الخدمات التعليمية والصحة والاسكان والثقافة المصرفية .
في حين كانت الخطتين الخماسيتين الثالثة والرابعة 1980 – 1985 و 1986 – 1990 تأشيريتان وذلك لأعطاء الدور الرئيسي في العمليات الاستثمارية الى القطاع الخاص , وذلك لتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر دعه يعمل دعه يسير , من دون ضوابط وذلك لتطبيق مفهوم الادارة العامة الحديثة , لذا لم يعد وضع الخطط من مهام الحكومة المركزية بل أن كل مؤسسة تضع خططها الخاصة بها ضمن مفهوم الادارة الاستراتيجية , من خلال وضع الحكومة لبرامج تحفيز اقتصادي , أو برامج اصلاح اقتصادي أو برامج اصلاح اداري أو سياسي , أو أن تقوم الحكومة بوضع خارطة طريق طويلة الأجل ضمن رؤية واضحة ومحددة الى المستقبل
ولكن الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة من خطط التنمية الاقتصادية أصبح يسر بالاتجاه المعاكس , حيث أخذ الاقتصاد الأردني يشهد حالة من الانكماش الاقتصادي مرتبط مع مجموعة من التغيرات الاقتصادية المحلية من أهمها : ارتفاع ملحوظ ومتسارع في حجم الدين العام وخصوصا المديونية الخارجية , وارتفاع ملحوظ ومتواصل في معدل البطالة , وضعف واضح في معدل نمو الايرادات المحلية , وارتفاع في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج . مما أدى ذلك الى انهيار في سعر صرف الدينار الأردني الرسمي من 8 , 2 دولار الى لكل دينار الى حوالي 41, 1 دولار للدينار الاردني الواحد , كل ذلك أدى الى انكماش شديد في معدل النمو الاقتصادي ليسجل نموا سالبا يقدر 7 , 10 % وارتفاع معدل التضخم الى 6 , 25 % عام 1989 . حتى أصبح الأردن عاجزا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه ازاء المديونية الخارجية , لذا لجأ الأردن الى صندوق النقد الدولي وطلب منه التوقيع على اتفاقية الاستعداد الائتماني , وعلى أثر ذلك تم وضع برامج التصحيح الإقتصادي والاجتماعي في الأردن منذ عام 1989 ومع الأسف حتى أيامنا هذه .
وبالإضاقة الى ذلك تبنت الحكومة رؤيا وخطط واستراجيات في محاور متعدد تجاوزت الاصلاحات في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية , ابتدأ من الأجندة الوطنية عام 2005 وكلنا الاردن عام 2006 والخطة الاستراتيجية الوطنية للسنوات 2015 – 2025 ورؤيا التحديث الاقتصادي للسنوات 2022 – 2030
كل ذلك كانت نتائجه , زيادة حجم الدين العام وعدم قدرة الاقتصاد الوطني من تسديد عبء الدين وبالتالي ارتفاع حجم الدين بنسبة عالية فاقت الناتج المحلي الاجمالي , وعجز متزايد في الموازنة العامة , وفي الحساب التجاري والجاري في ميزان المدفوعات , وتراجع معدلات النمو في الناتج الى مستويات منخفضة جدا , وارتفاع نسبة الفقر والبطالة .
وحسبما أرى أن سبب هذا الاخفاق في تحقيق أهداف الخطط والبرامج ورؤيا التحديث الاقتصادي يعود الى أسباب خارجية وداخلية وبعد انحصارها كما ذكر , لابد من السير في تحفيز ورفع كفائة الاستثمار من خلال تبني قاعدة الرصد الهكلي الذي تبنه تشيلي السابق الذكر وهو ( (Structural Fiscal Surplus Rule يتطلب ذلك, اعادة هيكلة مؤسسات الدولة فعلا لاقولاً والذي عملت عليه الحكومات المتعاقبة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى أيامنا هذه دون أي تقدم يذكر , رغم أنه منذ عقد الثمانينيات وعقد
5 / 5
التسعينيات من القرن العشرين والى أيامنا هذه تم انشاء هيئات تنظم قطاعات مستقلة اداريا وماليا تتولى كل منهما تنظيم قطاع معين , لتعزيز التنافسية وتقديم الخدمات بجودة عالية للمجتمع بدلا من الحكومة , وذلك العمل بتطبيق مفهوم الادارة العامة الحديثة للدولة . ولكن بقيت الوزارات المماثل عملها الى الهئات التي انشأت كما هي مما أدى الى التشابك وعدم الوضوح في أعمال الحكومة , كل ذلك أدى الى ظهور شكل جديد من الواسطة والمحسوبية , وهو الذي يعتبر أحد أشكال الفساد . فقد أصبحنا مؤخرا نسمع من رجال الأعمال هذه المقولة ” دون واسطة يصعب أن تنجز معاملتك مع الحكومة ” وهذا دليل على ضعف الشفافية .
وما هو متعارف عليه عند المختصين في الادارة العامة أنه كلما ضعفت الشفافية والمسائلة زاد الفساد . وحيث أنه ينظر للاصلاح الاداري بأنه رافعة الاصلاح الاقتصادي , وأن الاصلاح الاداري يعتبر متطلبا ضروريا لتوفير بيئة خاصة وجاذبة للاستثمار ولتعجيل النمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية المستدامة . علينا أن نتحمل حجم الأثر السلبي على الاقتصاد الأردني الذي أحدثه ضعف مسيرة الاصلاح الاداري في البلاد . ويبدو أن الحكومة لا يوجد لديها رؤية واضحة للاصلاح الاداري في القطاع العام بمفهومه الشمولي , وعوضا عن ذلك فقد انشغلت بالتفصيل وانجاز جزئيات هنا وجزئيات هنالك .
وفي مجال الاصلاح الاداري نود التأكيد على أهمية بناء المؤسسات الشاملة من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة . وقد أوضح خبراء الادارة لماذا تفشل الآمم في تحقيق الازدهار ومحاربة الفقر اذا كانت المؤسسات لديها مؤسسلت استحواذية , لذا فعلى الدول الراغبة في تحقيق الازدهار الاقتصادي أن تعمل على بناء المؤسسات الشاملة بدلا من المؤسسات الاستحواذية الموجودة فيها لتحقق الخطط والبرامج ورؤيا التحديث الاقتصادي أهدافها , التي وضعت من أجلها لا بعيدة عنها كل البعد مثلها مثل الغراب الذي أراد أن يقلد مشيت الحمامة فنسي مشيته ومشيت الحمامة .