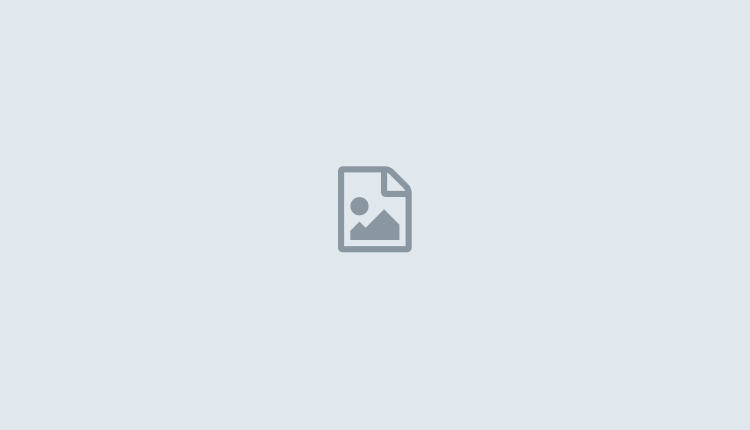في حال الدولة المدنية
I – الإسلام السياسي والدولة المدنية
(1)
الدولة المدنية، نتاج لتطور تاريخي شهدته المجتمعات البشرية، وهي ضرورة تاريخية، لا محيد عنها من أجل ملاقاة متطلبات الدولة العصرية، الدولة الحديثة التي من وحدة وتماسك مجتمعها تستمد وحدتها وتماسكها، وهي الدولة القائمة على المباديء/ الأسس التالية:
■ المساواة، بالدستور والقانون، في المواطنة لجميع أبناء الشعب بكافة مكوناته بغض النظر عن الإنتماء الديني، المذهبي، الجندري، الجهوي، الإثني، اللغوي، الإعاقي الخ..
■ الحرية، حرية الرأي والضمير في قضايا ومجالات الفكر والسياسة والإيمان والمعتقدات – ضمن ما يسمى بالحيّز الخاص -، إنما بحدود إحترام الآخر، أي عدم التجاوز على حرية الرأي عند الآخر– أكان فرداً أم جماعة – أو التطاول على معتقداته أو حتى المساس بها.
■ حياد الحيّز العام القائم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ضمن إختصاص كل منهما (ما يسمى بفصل الدين عن الدولة) وعلى قاعدة إستقلالهما، وهو إستقلال لا يلغي، بل يستوعب مساحة تداخل بينهما بقضايا معيّنة وفي مجالات محددة في المجتمع المدني والمساهمة في تنظيم الحياة الإجتماعية، في الأحوال الشخصية وإندراج المقاييس والقيم الدينية في قضايا الحق العام والقانون العام الخ..
■ الشعب هو مصدر السلطة وبالتالي فهو منشيء التشريع من خلال المؤسسات التي تعبِّر عن إرادته، أي إرادة مجموع المواطنين في الدولة الذين يرتبطون فيما بينهم بعقد إجتماعي توافقي؛ وهو التشريع القائم على الجمع بين الثابت والمتغيّر، تبعاً لتطور الشروط الموضوعية – المجتمعية والثقافية التي تمليه، ضمن ما يقدِّر الشعب (كشخصية معنوية إعتبارية وقانونية في آن) – من خلال ممثليه المنتخبين ديمقراطياً – أنه يقع في دائرة الصالح العام الذي يلبّي تطلعاته…■
(2)
1– الدولة المدنية، إذن، نتاج لعملية تاريخية، مضمونها إجتماعي، أو صراعي سياسي – إجتماعي، واكبت صعود البورجوازية في المجتمعات الغربية ذات التشكيلة الإقتصادية – الإجتماعية الأكثر تطوراً، وإنتصرت – أي الدولة المدنية – مع تقدم نمط الإنتاج الرأسمالي ليحل مكان نمط الإنتاج الإقطاعي، أي مكان التشكيلة الإقتصادية – الإجتماعية الآفلة.
بداية عبرّت الدولة المدنية عن مصالح البورجوازية الليبرالية، وعكست الفكر الليبرالي القائم على ركيزتي الحرية والمساواة بمضمون إجتماعي محدد يعكس مصالح الطبقة التي رفعت شعارهما. وفي هذا السياق نشير إلى 3 محطات تاريخية فائقة الأهمية:
■ 1688: تاريخ صدور «إعلان الحقوق» الذي من خلاله منح برلمان إنجلترا نفسه صلاحيات واسعة حيال رأس الدولة (الملك)، فأرسى الأسس الأولى للديمقراطية البرلمانية في الغرب وإن في إطار نظام سياسي ملكي – أرستقراطي، ما أدى إلى إنتقال إنجلترا إلى نظام الملكية الدستورية الذي يملك فيه رأس الدولة دون أن يحكم.
■1776: تاريخ «إعلان الإستقلال» الذي قاد إلى إنعتاق الولايات المتحدة من نير الإستعمار البريطاني، حيث تم التأكيد على أن البشر ولدوا متساوين وبحقوق غير قابلة للتصرف أو المصادرة: حق الحياة والحرية والنزوع إلى السعادة. ومن أجل تأمين هذه الحقوق تقوم حكومات تستمد سلطتها الشرعية والقانونية من موافقة المواطنين، ما يترتب عليه، في حال إخلال الحكومة بهذه المسؤوليات، تخويل الشعب بتغييرها أو إلغائها، وإقامة حكومة جديدة على هذه المباديء.
■ 1789: إنتصار الثورة في فرنسا على نظام الحكم الملكي تحت ثلاثية: حرية، مساواة، أخوة، والأخيرة بمعنى التضامن الأخوي تعبر عن المضمون الإجتماعي التعاضدي لشعار المساواة.
2- هذه المحطات التاريخية الثلاث شهدت ولادة الدولة المدنية في ثلاثة بلدان مفتاحية: الأولى (إنجلترا) بافتتاح عملية إصلاح واسعة للنظام القائم، والثالثة (فرنسا) بالإطاحة به، والثانية (الولايات المتحدة) بإقامة الإستقلال بعد التخلص من الإستعمار؛ هذه المحطات على تمايز مساراتها تاريخياً، إلتقت فيما بينها عند تقاطع إطلاق عملية ذات بعد كوني تمثلت بنموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية القائمة على الحرية والمساواة، وإن بمضمون إجتماعي يعكس محصلة التوازن الطبقي الذي نشأ جراء وفي سياق العملية التغييرية/ الثورية الواسعة التي إحتلت فيها موقع الصدارة البورجوازية الصاعدة، المتحدرة من منابت شتى.
3- غير أن إنتصار الدولة المدنية في البلدان المذكورة لم يَقُدْ تلقائياً إلى إنتصار المواطن بنفس المستوى، من خلال تعميم تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة. لقد إستلزم الأمر عقوداً من الزمن من أجل التطبيق العملي
– على سبيل المثال – لحق الإقتراع العام الذي يساوي بين المواطنين، من خلال إلغاء حق الإنتخاب المقتصر على المُلاّك، أو على دافعي الحد الأدنى من الضرائب، أو الإنتخابات على درجتين (لجمعيات إبتدائية تضطلع فيما بعد بدور إنتخاب ممثلي الشعب؛ ما يعني الفصل بين الإنتخابات كحق، والإنتخابات كوظيفة، ما يلغي – عملياً – الأولى، لصالح الثانية)… ومن أجل منح المرأة حق الإنتخاب والترشيح أسوة بالرجل، ولخفض سن إكتساب حق الإنتخاب والترشيح لتشمل هذه العملية قطاعات أوسع من الشباب.
4- كما إستلزم الأمر فترة طويلة تخللتها حروب أهلية مكلفة دماً ومالاً وإجتماعاً من أجل إلغاء العبودية في الولايات المتحدة (بكلفة 3/4 مليون قتيل) وعديد المستعمرات، قبل أن تنتقل إلى دول أخرى (وآخرها موريتانيا في ستينيات ق. 20)، ومن ثم لاكتساب وممارسة كامل الحقوق المدنية (الولايات المتحدة، حيث ما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن)، أو لإلغاء مظاهر التمييز العنصري (الأبارتهايد، كما كان الحال في جنوب إفريقيا)..
5- كما أن المساواة القانونية والسياسية إستغرقت طويلاً قبل أن تستقر على وجهة التقدم نحو إنتصار فكرة المواطن على أساس المساواة في المواطنة، إستلزم التقدم نحو المساواة الإجتماعية خوض نضالات لا تقل عن الأولى ضراوة ودموية قبل أن تُدفع خطوات إلى الأمام بمضمون العدالة الإجتماعية، بإعتبار أن ما هو أبعد – أي المساواة الإجتماعية، وإن على قاعدة «لكل حسب عمله» – هدف وطموح ينتسب إلى مرحلة تاريخية لمّا تستكمل شروط إنعقادها بعد، وهي مرحلة الإشتراكية المتقدمة في صيرورة الإرتقاء التاريخي للمجتمعات البشرية.
6- مع إتساع نمط الإنتاج الرأسمالي، تعاظمه وإنتقاله إلى مرحلته العليا، مرحلة الإمبريالية، جرى تعميم نموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية على أكثر من بلد في مجرى عملية تاريخية حوَّلت هذا النموذج إلى ظاهرة كونية تشمل عدد كبير من الدول في العالم.
إن التطور المتفاوت المتأصل كقانون في نمط الإنتاج الرأسمالي السائد، في مرحلته الإمبريالية، لا يضع مكوِّنات البنى الفوقية (ومنها، إن لم يكن أهمها الدولة) على نسق واحد. إن أي عملية تاريخية – مبدئياً وعملياً – معرضة للتقدم كما للإنتكاس، لكن المنحى العام على المستوى الكوني، صاعد لجهة التقدم – وإن بتفاوت – على مستوى إعتماد نموذج الدولة المدنية القائمة على الديمقراطية والحرية والمساواة السياسية والعدالة الإجتماعية.
إن هذا المنحى التطوري الصاعد – وإن كان بوتيرة دون الطموح والمرتجى – لا يلغي واقع الصراع القائم في بعض بلدان الدولة المدنية. لكن طبيعة هذا الصراع تختلف عما تشهده بلدان أخرى تقع خارج نصاب الدولة الديمقراطية التعددية، فهي لا تدور حول الهوية أو طبيعة الدولة أو مصير الكيان، بل على قضايا التطور العام ورفع تحديات المستقبل، إلى جانب معالجة المشكلات الإجتماعية والإقتصادية الخ..
وإن نشبت صراعات تطال الهوية والكيان كما هو حال كاتالونيا في إسبانيا، أو إسكُتلندا في بريطانيا العظمى، أو الفلمنك والفالون في بلجيكا، فإنها تدار بطرق ديمقراطية تنزع إلى تحقيق التوافق الوطني، وعندما يتعذر ذلك يتم الإحتكام فيها إلى آلية الأكثرية والأقلية، وليس إلى خيار الحرب الأهلية، التي لا تنتج سوى خاسرين■
(3)
1- لا تواكب الدول العربية عموماً، هذا التطور العام باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، بل سجلت في السنوات الأخيرة، ومنذ إندلاع الإنتفاضات الشعبية التي إجتاحت عدد من الدول العربية منذ نهاية العام 2010، شهدت – باستثناء ما شكلته التجربة التونسية – تراجعاً حاداً تأرجح بين إنهيار بنى الدولة القائمة وتفككها وتعاظم نفوذ ودور قوى الإسلام السياسي على مدارسها وأنواعها، أو تعاظم أهمية المرجعية الدينية في النص الدستوري (مصر).
إن طبيعة الدولة: مدنية أم دينية مطروحة بقوة على جدول أعمال المجتمعات العربية وقواها السياسية، فقوى الشد العكسي تدفع باتجاه الدولة الدينية، وأخرى تتبنى مقولة الدولة المدنية المطعمة دينياً. وثمة قوى وازنة تناضل من أجل الدفاع عن – وأحياناً – تطوير صيغة الدولة المدنية حيث هي قائمة، أو إرساء أسسها حيث مازال الصراع يدور حولها.
2- من موقع وبنيّة الإلتفاف على مفهوم «الدولة المدنية»، لجأت بعض الإتجاهات المؤثرة في بيئة الإسلام السياسي (كما حركة الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس في فترة صعودهما الجماهيري وتمددهما الإنتخابي) إلى إنتحال القبول، لا بل إدعاء السعي لإقامة الدولة المدنية، إما لأغراض الإستقطاب السياسي والجماهيري بتقديم نفسها كطرف وسطي معتدل لا يستتبع وصوله إلى السلطة إنشاء بنية تشريعية متطرفة ذات طابع شمولي، أو/ و تجنباً للإشتباك الدعوي والسياسي مع قوى أخرى – صاعدة بدورها – ضمن تيار الإسلام السياسي (كالإتجاهات السلفية، أو السلفية الجهادية..) الداعية صراحة إلى إقامة الدولة الدينية.
في هذا الإدعاء بقبول الدولة المدنية كلما وجدت في ذلك تلبية لمصلحة آنية، كانت هذه القوى تتجنب تعريف هذه الدولة بسماتها، أي بما يفترض أن تكون أو تطبع عليه، إذ كانت تكتفي بموضعتها في مكان ما بين حدّين مستثنيين: فهي ليست دولة يمسك بمقاليدها الكهنوت، لأن الإسلام لا يملك هذه البنية أصلاً كما هو حال المسيحية؛ وهي ليست دولة عسكرية بقبضة الجيش او المؤسسة الأمنية عموماً، وبالتالي فهي دولة مدنية، طالما أنها ليست كهنوتية ولا عسكرية(!).
3- إن هذا التعريف للدولة المدنية بما لا يجب أن تكون عليه، لا يخفي بالطبع موقف الإسلام السياسي الواضح فيما يتصل بسعيه لإقامة الدولة الدينية التي تجسد «حاكمية الله» على الأرض.. فهو لا يعترف بمقولة «الشعب هو مصدر التشريع»، باعتبار أن النص الديني هو مصدر التشريع، لأنه الوحيد القادر على توحيد القوانين التي خلقها الله مع القوانين الصادرة عن البشر، فالأخيرة لا بد أن تكون صادرة عن الأولى، أو تستند إليها، وفي أحسن الحالات تقوم بتأويلها.
الإسلام السياسي لا يعترف بحياد الحيّز العام القائم على الفصل بين الدين والدولة، فالإسلام دين ودولة بحسب حسن البنا. أما المساواة في المواطنة، فهي بسبب التمييز في «درجة المواطنة» لا تقوم إلا على أساس الإنتماء إلى الدين الواحد، وصولاً إلى المذهب الواحد، وعلى أساس جندري (جنس – إجتماعي) في كل الأحوال. أما الحرية فحدودها (وقيودها) هي العقيدة كما تفهمها المراجع الدينية على خلفية إجتهادات وتأويلات يصعب – للوهلة الأولى – التمييز فيها، أو الفصل بين ما هو ديني أو – بالمقابل – سياسي معبر عن مصالح فئات إجتماعية بعينها■
II – الجبهة الديمقراطية والدولة المدنية
(1)
1- في أدبياتها تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن تكون دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، دولة مدنية ديمقراطية. هذا ما أتى على ذكره بوضوح البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية ونظامها الداخلي في أكثر من موقع، وبالتحديد في سياق إبراز نضال الجبهة الديمقراطية من أجل:
■ «الإستقلال الوطني وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والمساواة وحقوق المواطنين، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل» (البرنامج السياسي، مقدمة الفصل الثاني).
■ و«من أجل التحرر الوطني والعدالة الإجتماعية والمساواة في المواطنة في إطار الدولة الديمقراطية المدنية،…» (النظام الداخلي، الفقرة 8 من الفصل بعنوان «(1) الحزب: التعريف والأهداف»).
2- في تبني هدف النضال من أجل «دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة»، يلاحظ أعلاه إضافة «.. المساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل»، التي قد تبدو – للبعض ربما – أن لا لزوم لها، باعتبار أن ما سبقها يؤدي الغرض ويفي بالمعنى. أما الإجابة على هذا، فهي بكل بساطة مايلي: إن البلدان العربية التي تقدم نفسها كدول (ذات أنظمة) مدنية، أكدت بالتجربة والممارسة أن النص على مبدأ المواطنة في دساتيرها لم يجنبها مفاسد ومخاطر ظاهرة التمييز السلبي وعدم المساواة بين المواطنين، التي أجحفت بوضع ومكانة وحقوق عديد المكونات الأثنية والثقافية والدينية في هذه البلدان.
وبالتالي، فإن المقصود بهذه الإضافة، التي قد يعتبرها البعض إستطراداً نافلاً، هو تحصين النص من زاوية التأكيد المزدوج على أن مبدأ المواطنة يعني بوضوح، بالنص كما بالممارسة العملية، المساواة بين المواطنين، كما أنه يعني أيضاً وبالتخصيص المساواة بين المرأة والرجل، الذي سنأتي عليه بمزيد من التحديد في الفقرة التالية..■
(2)
1- إن رفع الظلم والإجحاف والتمييز وعدم المساواة اللاحق بالمرأة في مجتمعاتنا العربية – مع ملاحظة التمايز في أوضاع المرأة بين بلد وآخر – لا يكون – كما يشيع البعض – برد «حقوق المرأة الشرعية» عندما تُسلب منها، وهي غالباً ما تسلب منها؛ كما لا يكون – وحده – بإقامة أحكام العدل وميزان الإنصاف والنزاهة.. التي تمنح المرأة حقوقها… فكل هذه الأحكام – بالنتيجة – وبمعزل عن النعوت الجميلة التي تضفى عليها، إنما تعبّر عن بنية قانونية بمرجعيات نصوصية واضحة، تعيدنا في العادة إلى مضمون «الحقوق الشرعية» وما يندرج في إطارها.
وبالمقابل، فإن المفهوم/ المصطلح المحصَّن، الذي يُغلق الباب أمام شتّى الممارسات والتفسيرات التي تنال من حقوق المرأة، هو: «المساواة»، والمساواة في كافة المجالات.
2- قد يعتقد البعض، ومن موقع المناصرة والتأييد لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كأساس ومرجعية للبنية القانونية الناظمة للعلاقات البينية وشؤون المجتمع، أن هذا المبدأ سيصطدم في مكان ما بالنص الشرعي. وعلى تسليمنا بهذه الفرضية، فإننا نعلم يقيناً، أن المرجعيات المختصة – عندما تتوفر الإرادة السياسية – قادرة على إيجاد المخارج وإجتراح الحلول التي تنتج بنية قانونية ملبية لمتطلبات وإحتياجات المجتمعات العصرية، الحديثة.. إنطلاقاً من مواءمة النص الشرعي مع غايته ومقاصده؛ التي لا يمكن أن تكون، ولا يجب أن تكون إلا في خدمة تطور المجتمع القائم على ركيزتي الحرية والمساواة، على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
ودليلنا على هذا سوابق عدة تمتد من حقل المال والإقتصاد، حيث القبول عملياً بالفائدة (المقابل العصري للربا) التي تشكل أهم أعمدة النظام المالي/ المصرفي في عالمنا المعاصر الخ..؛ إلى قانون العقوبات، حيث إلغاء تطبيق الحدود كالرجم وقطع اليد الخ.. بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة؛ مروراً بإسقاط التمييز المُذِل حيال بعض مكونات مجتمعاتنا، حيث إلغاء دفع الجزية، باعتبار أن قانون الخدمة الوطنية يسري تطبيقه على جميع المواطنين الخ..؛ وإنتهاءً بتجاوز حد الرِدة، كونه يعود إلى ظرف تاريخي محدد غير قابل للتكرار، كان يملي الدفاع عن الدولة الإسلامية الفتية المنطلقة بكل ديناميتها وزخمها في مطلع عهد الخلفاء الراشدين، وهذا ما يؤكده – على أية حال – النص على «حرية المعتقد والضمير» الذي ورد في الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد (26/8/2014) الذي يؤدي في ما يؤدي إليه إلى تجاوز «حد الرِدة» وإبطال مفاعيله■
(3)
1- إن إلصاق صفة التعميم على موقف الإسلام السياسي الرافض عملياً للدولة المدنية، وإن ناور أحياناً بادعاء قبولها، لا يلغي حقيقة وجود إستثناءات، كما هو حال حزب النهضة في تونس، عندما صوّب موقفه الأولي السلبي من الدولة المدنية بمضمونها الحقيقي، بموافقته على الدستور الجديد، الذي بعد أن أكد في توطئته على «.. المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات»، ينص بوضوح قطعي على أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون» في الفصل2 من الدستور، وهو فصل ركني ثابت – بحسب ما ورد فيه – لا يجوز إدخال أي تعديل عليه.
والمسلم به، أنه لولا إحتدام الصراع المجتمعي والسياسي في الحالة التونسية على قضايا جوهرية، لم يكن أقلها سخونة موضوع الدولة المدنية، ونسبة القوى التي تشكلت فعلياً في مجرى هذا الصراع لجهة الدفع بهذا الخيار، لما حسمت الأمور بنتيجة إعتماد صيغة الدستور الجديد. وعلى خلفية هذا الصراع، وإلمام كافٍ بوضع المجتمع التونسي باصطفافاته وتوازناته، تمتعت قيادة حزب النهضة بدرجة كافية من النضج والمسئولية الوطنية للتعاطي الواقعي مع الخيارات التي إعتمدتها غالبية الشعب التونسي في إقرار الدستور بصيغته المحدثة.
2- ولعل الإستخلاص المباشر والمفيد من وقائع الحالة التونسية يؤكد، مرة أخرى، وأقله، على أمرين:
■ الأول – أن الحوار الدائر حول خيار الدولة المدنية، كي يثمر، يجب أن يدار على أوسع نطاق في المجتمع بمختلف دوائره وفي صفوف الحركة الجماهيرية، ولا يجب أن يقتصر على أو ينحصر في الطوابق العليا بالدائرة المغلقة للجان الإختصاص الحيادية شكلاً والمتحيّزة لصالح المواقف المساومة على الدولة المدنية، المناقصة عليها، والجاهزة لتقديم تنازلات تخدم بأشكال مختلفة الطرح الآخر: الدولة الدينية، أو الدولة ذات السمات الدينية، أو الدولة المطعمة دينياً.
■ الثاني- إن قوى معيّنة من قلب تيار الاسلام السياسي، قوى تتحلى بدرجة معقولة من التفكير الواقعي المستنير، وكما بيّنت التجربة، هي قوى جاهزة – في التحليل الأخير – للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته وإستعداداته، لكن أيضاً بتوازناته، من خلال الإقدام على خطوات ملموسة تتقدم على طريق الإقتراب من مفهوم الدولة المدنية، خطوات تنطوي على القبول بتطوير البنية القانونية للمنظومة الدينية بالإتجاه الإصلاحي الحداثي، العصري، أي التقدمي في نهاية المطاف■
(4)
إن التوقف أمام الدولة المدنية لاستئناف الحوار حولها في الحالة الفلسطينية، يكتسي أهميته أيضاً من زاوية الدراسة المعمقة لنتائج أعمال «لجنة صياغة دستور دولة فلسطين» التي أنجزت أعمالها بعرض «فلسفة ومرتكزات عمل اللجنة» و«مسودة الدستور» للنقاش في الدائرة الضيقة المختصة في أيلول (سبتمبر) 2015، قبل أن تعود للإلتئام مرة أخرى للبحث في الملاحظات والتدقيقات التي سترفع إليها.
في هذا السياق يسترعي الإنتباه أسلوب صياغة ما يتصل بـ «المساواة» في «فلسفة ومرتكزات عمل لجنة صياغة الدستور» التي تجنبت إستخدام صيغة «المساواة بين المواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة» في الفقرتين ر( ) ، و ز( ) ذات الصلة بالموضوع، لصالح إعتماد صيغة «عدم التمييز» التي لا تضاهي من حيث الوضوح القطعي ولا تصل إلى مستوى صيغة «المساواة» المحصّنة بإزّاء أي تأويل أو إجتهاد آخر ينتقص من مضمون المساواة أو يضعفه■
19/10/2015