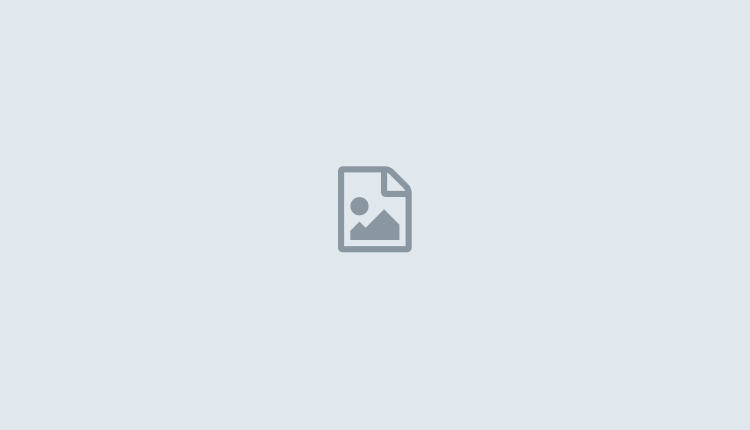لا للعسكر ونعم للعسكر
لا للعسكر ونعم للعسكر
د. مراد الكلالدة
قد نفهم أن غالبية الناس تحب أن تنأى بنفسها عن السياسة وتنشغل بتصريف حياتها اليومية، ولكننا لا نفهم أن ينأى السياسيون والمثقفين بأنفسهم عن التواصل مع الناس حينما يكونوا في أحوج الأوقات الى سماع رأيهم والإسترشاد بمواقفهم. فقد لاحظ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إختفاء قادة رأي كانوا يستغلون هذه المنابر لإيصال أفكارهم الى الناس ودعوتهم للإنخراط في نشاطاتهم وحراكاتهم الشعبية.
لقد كنا ننتظر بضعة كلمات واليسير من الأسطر لنستنير بمكنون خبراتهم لمساعدتنا على تجاوز دقائق حيرة أو ساعة غضب أو يوم مضطرب في محيط هائج أصبحنا فيه مهددين بلقمة العيش وفقدان الوظيفة ورداءة التعليم وإنعدام الصحة. فما الذي حدى بالقادة الى هذا الإنكفاء عن الأضواء، قضية أردت أن أسلط الضوء عليها في مقالتي هذه.
لقد نجح العرب في تكوين نواة لأمة عربية محور قيمتها الأساسية Core Value هو الدين، ولا عجب في ذلك لأن جميع الأديان السماوية قد ظهرت في المثلث الجغرافي (فلسطين-مصر- الجزيرة العربية). وقد لعب الدين دوراً إيجابيا في نقل المجتمع من حالة العبودية إلى التحرر، وقد كان للدين الإسلامي الدور الأساسي في الإنتشار من أوروبا حتى الصين معتمداً على العربية كلغة تواصل وعلى التسليم بالغيبيات كمعتقد. ولكن النظام السياسي المستند الى الفكر الديني قد تمسك بنصوص محددة ومرتبطة زمنياً بما حدث قبل 1440 سنة، فأصبح من الصعب التحرر من هذا القيد التاريخي ولا سيما أن الإسلام استند الى فكرة أن محمداً عليه السلام آخر المرسلين، فلا جدال بعد ذلك، ولا إجتهاد في النص.
لقد أربكت هذه القيود الحركات الدينية والتي انقسمت على بعضها بين الأصولية التي تدعو الى التمسك الحرفي بالنص وبين الليبرالية الدينية التي طوعت النص لمجارة العلم والعالم فلعبوا سياسية إنفتاحية ظاهرياً وإنغلاقية داخلياً، وما كان هذا التصرف الإ المُنقذ لهم من الإندثار لأن النص لم يعد مقنعاً للكثيرين أمام الإكتشافات العلمية التي أثبتت بأن السماء عبارة عن طبقات غازية ولا تحتاج إلى أعمدة لرفعها وأن الأرض كروية لا محالة، وأن الإستنساخ مُمكن بدون الذكور.
لقد وجد الفكر الديني له موطء قدم في العالم الجديد، ولكن ماذا بشأن الفكر العلماني المناقض من حيث المبدأ والتطبيق للفكر الديني حتى ولو حاول أياً من الطرفين الضحك على الآخر بنص من هنا أو تأويل من هناك، فإن التناقض قائم ومرشح للتصعيد لا محالة.
وللإجابة على ذلك يجب علينا أن ننتهز الفرصة التاريخية التي نعيشها والتي تُذكرنا بما مرّت فيه أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي حيث إنتصر النهج الداعي إلى تحكيم العقل للوصول إلى الحقيقة، وما كانت البروتستانتية إلا حركة تجديد ديني ساعدت على نجاح منهج العقل، أوتستكثرون علينا تحكيمنا للعقل؟ ومن المعلوم بأن ما وصلت اليه أوروبا وأمريكا ودول شرق أسيا لم يكن ليتم دون إنتهاج الفكر العلماني كمنهج حياه، فلماذ إذن يسعون لربطنا بلجام الخيول المجنحة وحجر هنا وجبل هناك، ويدعمون من لا يؤمنون بالديمقراطية على أنها كفر ولا يجيزون الحريات الشخصية لإنهاء إبتذال وزندقة ومجون.
جوابي على ذلك هو أن المحرك الأساسي للعالم الجديد هو المصالح الاقتصادية، فكل دولة أو تكتل يسعى لإضعاف الآخر، وإلا كيف سيتم شفط بترول العرب ولو ساد الاستقرار في العراق لما تمكنت الولايات المتحدة من سرقة تريليونات الدولارات في غضون عشر سنوات من الاحتلال غير المباشر للأرض.
ما يجري في الدول العربية هي تحولات إجتماعية طال إنتظارها وهذه فرصة لقوى التحرر لدفع المجتمع نحو التقدم والسلام المجتمعي. مجتمع يذهب فيه الناس الى عملهم دون فصل مكاني بين الرجال والنساء، ويمرح فيه الناس بحفلات مختلطة شريفة عفيفية يتعانقون فيها ويرقصون معاَ على أنغام موسيقى الرآي دون التفكير بالتزاوج. مُجتمع نقرأ فيه الفلسفة ونناجي الله الكائن فينا دون مناداة أو نكزة مُطوع. حياة نشرب فيها ما طاب من النبيذ ولذ من اللحوم والخضروات ونضحك ونمرح ونتسلى دون زجرة من ملتحي أو تكفير من جاهل.
ما جرى في مصر هو إنعتاق من قيود طغمة مبارك وعصابته، وقد رضي المصريين بنتائج الصناديق وحكم الدكتور مرسي رئيساً، ولكنه إختار أن يكون رئيساً لجماعة وليس رئيساً لمصر، وإختارت جماعة الإخوان المسلمين التفرد بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية وسعت الى الإستحواذ على السلطة القضائية، فهّب الشعب ليقول لا مرة أخرى لحكم التفرد، فما أن هربنا من دلف جماعة مبارك بتنا تحت مزراب جماعة الإخوان.
لا كبيرة قالها حشد هائل من المصريين يقدر بثلثي الشعب المصري، مطالبين الرئيس مرسي بإنتخابات مبكرة، نعم هذه كانت مطالبهم، فأبى وإستكبر وقال على جثتي ومن يرمينا بالماء نرميه بالدم. وحينها تدخل الجيش المصري معطياً جميع الأطراف مهلة للوصول إلى حل. وما أن انتهت المهلة وعشرات الملايين تملأ الشوارع والطرقات، حَسم الجيش الأمر وعزل الرئيس ليفتح الباب للأغلبية الشعبية لإكمال مسيرة التحول الاجتماعي.
وقد قبل المصريون لإنصار الرئيس المعزول بحقهم في التظاهر للمطالبة بالوصول إلى حل سياسي، إلا أن قيادة الأخوان المتطرفة عسّكرت الميادين وملئت التوابيت بالأسلحة والذخائر وعطلت الحياة المدنية مُغلقة الأبواب في وجه إلى حل سياسي عارضين مطلب تعجيزي ينادي بعودة رئيس مخلوع بإرادة شعبية، ورفعوا شعار، نحُن ومِن بَعدنا الطوفان، وسنحرق مصر، وسنُشعل سيناء، فقّتلوا ونكلّوا بجنود الجيش المصري ووصفوه وما يزالون بأقرف الألفاظ، وأصبح موتاهم في الجنة وقتلى الآخرين في النار.
لقد إنسحب ما يجري في مصر على ما يدور في باقي العالم العربي وقسّمنا الإخوان إلى فسطاطين، الأول ربعاوي مؤمن يحمل بطاقة دخول الجنة في جيبه، والثاني كافر إلى النار وبئس المصير. عن أي مصير تتحدثون يا أخوان، مصير رجعي عدمي تكفيري، وهل علينا أن نكرر مآسي الإسلام السياسي منذ إغتيال عمر إبن الخطاب رضي الله عنه، وقتل عثمان إبن عفان وتصفية أول من أسلم من الصبيان علي إبن أبي طالب كرّم الله وجهه في شهر رمضان. فكركم هذا قد إنحرف عن الرسالة السماوية السمحة وأنتم طُلاب سلطة ترفعون القرآن الكريم في وجه كل من خالفكم وكأنكم أوصياء على القرآن ووكلاء السماء على الأرض.
لم يتدخل الجيش المصري إلا بعد أن طلب إستفتاء جديد من الشعب المصري وسأل الفريق السيسي الشعب، ما أنا بفاعل، فجاءه جواب الأغلبية الساحقة بأنك مفوضّ لإنهاء الإعتصام الذي عطل حياة المصريين ونكدّ عيشتهم، فالقى الإخوان والأخوات وأطفالهن بأجسادهم أمام المدرّعات وصَعد قناصتهم إلى مآذن الجوامع (تماما كما حصل سنة 35 هـ، عندما رمي أحد حُراس عثمان بن عفان سهما نحو أحد الثوار، وهو نيار بن عياض الاسلمي فقتله، فقال الثوار لعثمان: إدفع إلينا قاتل نيار بن عياض فلنقتله به، فقال: لم أكن لأقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي).
التاريخ يعيد نفسه، فتحصن مؤدي مُرسي في المساجد وأرادوها دموية ونار … نار تأكل الأخضر واليابس ونجحوا في الإصطدام مع الشرطة والجيش ليستعملوا جثامين المصريين كقميص عثمان يجولون فيه بين الأمم طالبين الثأر.
الغرب وأمريكا رأس الحية، تلذذت بما آلت إليه الأمور فباتت تنصر الطرف الأضعف حتى يشتد عوده لمواصة الإقتتال وفقا لسياسة فرّق تسد Divide and Conquer ولتحصد ما قد زرعت على مر القرون من جماعات التكفير الدينية الجاهزة للإنقضاض على أي شيء يتقدم نحو الإنسانية والمساواة.
وفي الختام، أين نحن مما آلت إليه الأمور، هل نسلم لحملة قمصان القتلى الملطخة بالدم أو نرمي بثقلنا خلف الدولة المصرية للحفاظ على وحدتها، والجواب هو في قولنا: نعم للعسكر الذين فوضهم غالبية الشعب المصري لإدارة شئون البلاد في مرحلة إنتقالية لن تطول، وإن إستحلى العسكر كرسي الحكم سنقول: لا للعسكر دافعين، بذلك المجتمع خطوات إضافية إلى الأمام. ولن نستطيع تحقيق ذلك ما لم نتوحد على تحديد الأهداف المطلوبة في هذه المرحلة من تاريخنا وأهمها السير نحو الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة. ولهذا إفتقدنا الخالدين على الفيسبوك وإشتقنا الى عبارات لميس أندوني التحررية وثقافة الأكاديميين التنويرية ومنشورات المواقع الإلكترونية المحترمة، نحن في إنتظار نَفس شُركائنا في النضال لتوعيتنا والأخذ بيد المضللين من الناس في مواجهة الإرهاب.