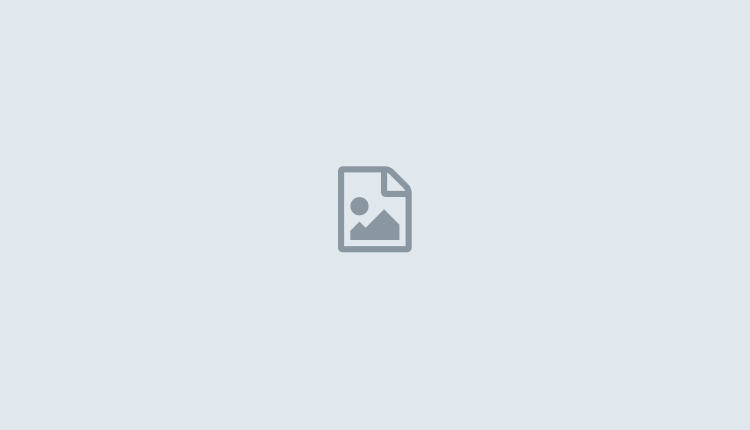البلطجة من الجامعات إلى الشارع و بالعكس!
كدنا نصدق أن “ملف” البلطجة” أغلق تماما، وأن أنظارنا يجب أن تتوجه إلى “العنف” الذي عاد مرة أخرى الى جامعاتنا، لكن يبدو أن ثمة من يريد أن “يغرقنا” في دوامة “العنف” من جديد.
أنا لا أتحدث عن “أصحاب القنوات” الذين تعهدوا بزجر “المطالبين” بالإصلاح وإعاقة مسيراتهم، وتلقينهم “دروسا” للالتزام ببيوتهم، بل عن ظاهرة “البلطجة” التي تعددت “ماركاتها” ابتداء من المتخصصين بتأديب خلق الله الذين تجرأوا وأعلنوا عن رأي مخالف كما حدث للداعية د. الشواهنة الذي فوجئ قبل يومين بـ”تكسير” سيارته أمام بيته، الى “الخبراء” بنشل “حقائب” النساء السائرات في الشوارع، إلى “عصابات” فبركة الحوادث المرورية للحصول على تعويضات تأمينية، وصولا إلى “البلطجة” المقنعة التي يمارسها البعض لابتزاز الآخرين بقصد الحصول على “ثمن” تحت “التهديد” بالتشهير أو نشر الفضائح.
أرجو من القارئ الكريم ألا يتهمني بخلط “الأسماء” والعناوين، فأنا أدرك تماما أن ثمة جرائم تصنف تحت بند “السرقة” وأخرى تحت بند “الاحتيال”.. وهكذا، لكنني أصر على وضعها جميعا في اطار “البلطجة”، ذلك اننا تعودنا فيما مضى على رصد مثل تلك الجرائم، وكنا نعتقد – رغم تصاعدها – انها تعكس ما أصاب مجتمعنا من تحولات وأزمات في قيم الناس وظروفهم، ونحن لسنا استثناء هنا، فمثل تلك الجرائم تتكرر في بلدان اخرى، لكن الفارق ان تلك البلدان قابلتها بـ”عقوبات” مغلظة، واستنهضت الدولة المجتمع للمساهمة بالتصدي لها.
الاختلاف بين هذه الجرائم ليس اختلافا في”الموضوع” بل في الدرجة، والأخطر من ذلك اختلافها في “التوظيف”، فالبلطجة التي توظف وتستخدم لغايات سياسية اسوأ من تلك التي تستخدم لأغراض “جرمية” سواء أكانت بدافع “الادمان” على ارتكاب الخطأ او العوز والحاجة.. لكن ما يهمنا – هنا – هو أن هذه “البلطجة” انتقلت من الشارع الى الجامعات، وبالعكس، وأصبحت “لعنة” تهدد أمن مجتمعنا واستقراره لا سيما في اقطارنا التي ما تزال تحتكم لمنطق “العشيرة”، والثأر، وترفض ان تتعرض للإهانة بلا رد.
لا أريد هنا أن أعبر – وقد سبقني الكثيرون لذلك – عن رفضي لكل ما يحدث في مجتمعنا من “بلطجة” ولا أن اشير الى “الأصابع” التي تقف وراءها، لكن يكفي ان اشير الى مسألتين: إحداهما ان “شيوع” هذه الظاهرة يقوّض ما فعلناه في مجال “الإصلاح” وما ننتظره من انفراجات سياسية واجتماعية، وبالتالي فإن تبريرها تحت أي عنوان يعني أننا ما زلنا في دائرة “الانكار” الأمر الذي يفوّت علينا فرصة معالجتها ومواجهتها “بالقانون” وبالقانون وحده، أما المسألة الأخرى فهي ان مهمة المواجهة لا تتوقف فقط على “الحكومة” واجهزتها الأمنية، صحيح ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن الصحيح ايضا أن هذه المهمة تقع على عاتق الإعلام الذي يفترض ان ينهض بمسؤولياته بكشف الظاهرة وتوظيف ما يلزم من مخزون ديني وتاريخي واجتماعي لتنوير المجتمع بـ”حالة” مجتمعا فيما مضى، وحالته اليوم بعد أن تغلغلت مثل هذه “الجرائم” فيه، كما تقع المسؤولية أيضا على علماء الدين والتربية ومؤسسات القانون وفقهائنا الاجتماعيين وقبل ذلك الفاعلين السياسيين الذين يجب أن يخرجوا عن صمتهم، وأن يحددوا – بصراحة – مصادر هذا العنف وأطراف “البلطجة” الذين يعبثون في مجتمعنا بلا وازع من ضمير أو أخلاق.
نريد أن نودّع إلى غير رجعة ظاهرة “البلطجة” والاستقواء على الدولة والقانون، ونريد أن نتفرغ للإجابة عن أسئلة، هي:
لماذا تعتقد أغلبية الناس أننا نسير في الاتجاه الخطأ، كما أوضح آخر استطلاعات الرأي؟
أليس من حق مجتمعنا أن يسترد أنفاسه وعافيته وأن يصحو وهو مطمئن على حاضره ومستقبله؟
أليس من حق الناس في بلادنا أن يبددوا اليأس والإحباط الذي صنعته أخطاء سياسية ما زالت تقيّد ضد مجهول؟