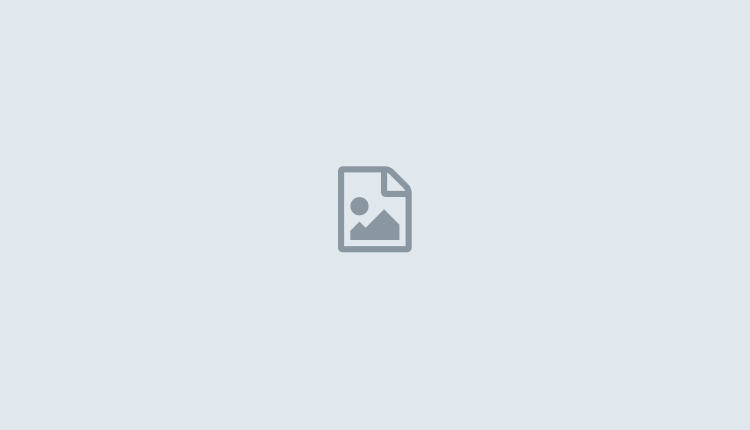مشكلة انطفاء «الحلم » في مجتمعنا..!!
لست أبالغ إذا قلت : إن كل صور الخلل التي كنا – ولا نزال – نشكو منها في مجتمعنا سواء تعلقت بالانحراف او الجريمة، او التفكك الاسري او العنف او غيرها مما يطفو على الساحة او يتغلغل في الاعماق، لا يمكن ان يقارن من حيث خطرها، بهذا “الموات” الذي اعلن عنه احد الذين سألتهم: كيف تفكر؟ فأجاب: ومن قال انني افكر؟ وهل ثمة ما يدعو الى التفكير؟ فلقد اختصر صاحبنا بقصد او بدون قصد، تلك الحالة التي اشرت اليها فيما سبق، على اعتبار ان صور الخلل التي تتعلق بأي جريمة او فساد او فعل خارج على القانون لا تصدر الا عن اشخاص يفعلون ويتحركون فيخطئون وقد يصيبون، بينما يتعلق هذا الذي اختاره صاحبنا “بحالة” من الغيبوبة او الشلل او قل “الموات” الذي لا يمكن لنا بعده ان ننتظر شيئا لا على صعيد الحاضر ولا المستقبل، اللهم الا اذا كان على شكل (قيامة)، ولا تسأل حينها عن الفزع والاهوال ورعب خروج الميتين من القبور. لم يكن السؤال الذي تبادر الى البال: من اوصل هؤلاء الى هذا الطريق المسدود، وانما كيف وصلوا، ومتى، ولماذا؟ وهي اسئلة اجدني غير قادر على الاجابة عنها او – على الاصح – غير راغب في تحريرها – هنا – لان غيري – ربما – اقدر على الاجابة عنها، او لان المسألة تتجاوز تقديم النصائح او الاقتراحات او حتى الاشارة الى الطرق الوعرة التي انتهت – بما فيها من عثرات – الى هذه النقطة المؤسفة من العزلة والانطواء. لكن ذلك لا يمنعني من الحديث عن جانب واحد من المشكلة وهو “انطفاء” الحلم، بسياقه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من حياتنا، على اعتبار ان هذا “الانطفاء” الذي لا يختلف عليه احد، كان احد الاسباب المباشرة التي افرزت ما نشكو منه الآن، سواء على صعيد “فقدان الشهية” للبحث عن النموذج او القدوة او البطل ام على صعيد انعدام جدوى التفكير والعمل ومحاولة التجديد والامل. ولن اذهب بعيدا اذا قلت بأن غياب “روحنا” الاجتماعية كان وراء هذا الانطفاء ، حيث لم تعد في مجتمعنا تلك الالفة والمحبة التي كنا نستشعرها قبل عقود، وحيث لم نعد نجد بين اسرنا ذلك الدفء الذي كان قادرا على جمع القلوب وصهرها في مواسم واحدة، للاعياد والاتراح على حد سواء، وحيث اختفت من بيننا تلك المصطلحات السحرية التي كانت تعبر عن مجتمع “العونة” الذي يسوده التكافل لا التناحر، والمشاعر لا مجرد المصالح، والبساطة والعفوية والبركة والقناعة، لا الصراعات والنميمة والانعزالية والحسابات المعقدة والمظاهر الخادعة. وفي غياب هذه “الروح” الاجتماعية بما تفيض به من مضامين وتعبيرات لم نسلم من تسلل ارواح اخرى او قل ما يشبه الارواح الاصطناعية الى مجتمعنا، اما كيف تسللت ودخلت، فلا اخال احدا لا يتذكر ما طرأ من تحويلات وانقلابات علينا، في سياق التشريعات والقيم والاحداث العاصفة التي تعرض لها مجتمعنا على امتداد العقود الماضية مما لا مجال لشرحه الآن، واما كيف ننجح في طردها او محاصرتها – وهذا الاهم – فسيتدعي اكثر من اجابة واكثر من محاولة واحسب ان في مقدمتها استعادة تلك الروح التي فقدناها، وهي مسؤولية تتجاوز قدرة الحكومات ورغبتها في آن، الى المجتمع بكامله، والافراد حيثما ألجأهم اليأس والقنوط الى الجدار، ثم لا بد من اجل ذلك ومعه، من رفع كل الاسيجة التي تحاصر عقول الشباب واحلامهم ومن ازالة ما تراكم من حواجز تحول دون حقهم في التفكير والتعبير والامل والتخيل.. وتحصينهم ضد العزلة والانطواء وضد معوقات الشلل والعجز، التي لا تصيب الاجساد فقط، بل الاذهان والذاكرة ايضا. بقي ان اضيف بأن كثيرين سيشيرون الى ما يفعله الوازع الديني على صعيد استعادة الروح للشباب، وانا لا انفي ذلك وخاصة امام هذا الاندفاع المشهود نحو “التدين”، لكنني اريد من هذه الاستعادة ان تشمل “ روح” الدنيا اولا.. بدل ان تتوجه كليا نحو الاخرة بحيث تكون “روح” الدين هذه باعثا لاحياء روح الدنيا وروح المجتمع وروح العمارة التي انتدبنا الخالق لخلافته في بنائها ورفع مداميكها واحلام المقيمين فيها والعابرين.