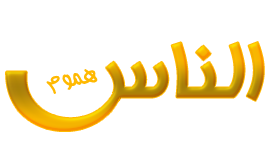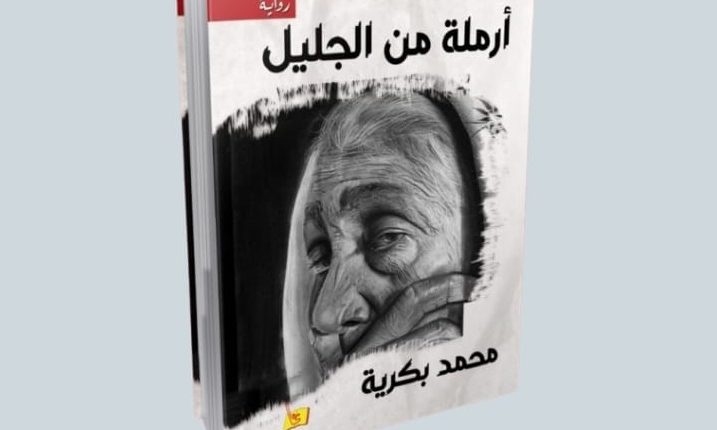(دراسة وصفية تحليلية) عبدالله محمد النجم – جامعة الإسراء للبعد الزمني في رواية (أرملة من الجليل) لمحمد بكرية
وكالة الناس – البعد الزمني في رواية (أرملة من الجليل) للكاتب: محمد بكرية، (دراسة وصفية تحليلية)عبدالله محمد النجم – جامعة الإســــــــراء
الملخص: هذه دراسة تُعنى بالبعد الزمني في إحدى الروايات العربية الحديثة، وهي رواية (أرملة من الجليل) للكاتب محمد بكرية، حيث تقف على تقنيات البعد الزمني، من خلال عرض الشواهد والنصوص المرتبطة بهذه الأبعاد والتقنيات وتحليلها، بما يُبرز جماليات توظيفها في النص الروائي، وبما يحقق الفائدة والغاية المرجوة من هذه الدراسة.
اتبع الباحث خلال إجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال سبر أغوار النص الروائي، وفقراته المتعلقة بالبعد الزمني في الرواية، والوقوف عليها بما يتسع له المجال، ويبرز قيمة البعد الزمني، وأثره على المتلقي والنص.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن رواية (أرملة من الجليل) تُعد توثيقا مهما لأحداث تاريخية مرَّ بها الشعب الفلسطيني، وأن المؤلف أجاد في توظيف تقنيات الزمن المتنوعة مثل: الحذف والاسترجاع والمشهد والتلخيص والوقفة الوصفية، وبما يزيد النص قوة وتأثيراً.
الكلمات المفتاحية: رواية، البعد الزمني، أرملة من الجليل
المقدمة: الأدب العالمي عموماً، والعربي على وجه الخصوص، ما زال حافلاً بكثير من التفاصيل والوجوه والرسائل التي تُعبر عن تجارب إنسانية، أو تؤدي مضامين حياتية في نواحي الحياة على اختلاف صنوفها، وهذه المضامين والتفاصيل تستحق الدراسة والتبحر وسبر الأغوار لاستخراج مكنوناتها، وعرضها للمجتمعات المتابعة، وبالتالي تحقيق الفائدة العظمى، والغاية الأسمى من هذه الأعمال الأدبية.
وفن الرواية أحد هذه الأجناس الأدبية وألوانها، بل إنه يكاد يتربع ويحتل المرتبة الأولى من بين هذه الصنوف الأدبية، فهو فن ما زال يتسع ليستوعب متطلبات الحياة بتصوراتها وعقدها وقضاياها المختلفة، وبالتالي فإن “الرواية هي الحامل الأدبي المنطقي لثقافة أضفت في القرون القليلة الأخيرة قيمة جديدة تماما على الأصالة وعلى الجدة، وبذلك كانت جديرة باسمها”[1] بل إن هذا الفن الأدبي فيه من المرونة ما يجعله يستوعب كثيراً من الألوان الأخرى أو أجزاء منها، بحسب ما يقتضيه الحال والمقام، فالرواية “تسمح بأن نُدخل إلى كيانها جميع أنواع الأجناس التعبيرية سواء كانت أدبيه (قصص، أشعار، قصائد، مقاطع كوميدية) أو خارج أدبية (دراسات عن السلوكيات، نصوص بلاغية وعلمية ودينية…إلخ) نظرياً، فإن أي جنس تعبيري يمكنه أن يدخل إلى بنية الرواية، وليس من السهل العثور على جنس تعبيري واحد لم يسبق له في يوم ما أن ألحقه كاتب أو آخر بالرواية وتحتفظ تلك الأجناس عادة بمرونتها واستقلالها وأصالتها اللسانية والأسلوبية”[2] وبالتالي استحقت الرواية كفن أدبي هذا التفوق على سائر الصنوف الأدبية الأخرى في العصر الحديث.
وقد اختار الباحث هذا الفن من بين الفنون الأدبية، وآثر أن تكون الرواية عربية حديثة، لتكون موضوع الدراسة، فكان اختيار رواية (أرملة من الجليل) للكاتب: محمد بكرية، ودراسة البعد الزمني في هذه الرواية، لما وجده الباحث فيها من مادة دسمة تُغطي هذا الجانب، إضافة إلى أنها تُعنى بأحداث لا تنفك عن تاريخ الأمة ككل، وقصة تلك الأرملة ذات العشرة أبناء، بما فيهم كاتب الرواية (محمد)! فهي تأخذ طابع الرواية التاريخية من جهة، وطابع السيرة الذاتية من جهة سردها لأحداث متعلقة بالمؤلف وعائلته ونشأته وظروف معيشتهم ومعاناتهم مع الاحتلال في منطقتهم (الجليل)، وهي على ارتباط تام بالمكان الذي عاش فيه الكاتب، بل وجرت معظم أحداث الرواية فيه، بل إنه مصدر ذلك النسيج الأدبي والفني الذي خاطه الكاتب في روايته، وهو أيضاً على تماس مباشر بتلك الأرملة (أرملة الجليل)! ولا غرابة في ذلك! “فالأديب لا يعيش في فضاء هلامي غير محدود المعالم، ولا في طبيعة متعددة الظلال، وإنما في واقع معيش، يحس بكل ركن من أركانه، والعمل الأدبي المنتج هو انعكاس للمكان، ومجال الحركة فيه”[3] وبالتالي فهو أجدر بتوثيق وتصوير ما عايشه أو عايشته تلك الأرملة والدته، أو حتى مرَّ بالمجتمع ككل في تلك الأيام، فقد “كتبت الرواية العربية التاريخ المعاصر الذي لم يكتبه المؤرخون، متطلعة إلى تاريخ سوي محتمل، وحالمة بمدن تعطي الرواية قراءة مجتمعية”[4] لذلك فإن معظم أحداث الرواية يمكن إسقاطها على معظم العائلات الفلسطينية في تلك الحقبة وحتى الأن، ومما لا شك فيه أن “الروائي الفلسطيني لا يريد أن يستبقي الصورة وحسب، الصورة التي تتعرض للتغيير بفعل متعمد يهدف إلى تزييف التاريخ والواقع معا! إنه يسجل حقه في وطنه، وعلاقته المستمرة به، سواء كان يعيش فيه أو كان منفيا عنه”[5] ورواية (أرملة من الجليل) ظهر فيها هذا التسجيل والتوثيق للأرض والإنسان والوطن والتاريخ.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الرواية تُبرز كثيراً من الأحداث التي كانت خلال طفولة الكاتب، فهو يستذكرها ويسطرها لأهميتها التاريخية، وحتى العائلية، وهذا أمر لا يمكن إغفاله؛ كون هذه المرحلة تُعد مصدراً غنياً لاستلهام تلك الأحداث، ذلك “أن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأكثر أهمية في حياة الإنسان، إذ تأخذ في مراحلها المتعددة ما نسبته الثلث إلى الربع من حياته في المعدل العام للسن البشري، عدا أنها أكثر المراحل تخزيناً للأحداث والمواقف والذكريات التي يمر بها، إذ في الغالب تُخزن أحداثها في الذاكرة العميقة التي تحفظ رموزها أطول فترة من الزمن مقارنة بالذاكرة السطحية التي سرعان ما تزول منها الذكريات”[6] لذلك، جاءت هذه الرواية توثيقاً لما عايشه ذلك الطفل خلال مراحل متعددة، وواكبت تطورات تاريخية على مستوى العائلة والقرية والوطن وحتى الأمة.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، خلال إجراء هذه الدراسة، وبالوقوف على أبعاد الزمن وتقنياته، وتوظيفها في رواية (أرملة من الجليل) من قبل الكاتب، وبالتالي عرض الشواهد من النص الروائي، وتحليلها بما يظهر استخدام تقنيات البعد الزمني موضوع الدراسة، وبما يحقق الفائدة، والغاية المرجوة منها.
أما الدراسات السابقة، فلم يظهر للباحث – في حدود معرفته – أن سبق وأُجريت دراسة للبعد الزمني في رواية (أرملة من الجليل)، ولكن هناك عدد من الدراسات المتعلقة بهذا الجانب في روايات أخرى، منها: دراسة بعنوان : “قراءة في الزمن: دلالاته وتقنياته في رواية (امرأة بلا ملامح) لكمال بركاني”[7] للباحث: عبدالعزيز نصراوي، تطرقت الدراسة لأهم تقنيات الزمن: التلخيص والوقف والحذف والمشهد والاسترجاع والاستباق، ثم خاتمة تضمنت أهم نتائج الدراسة، ويرجح الباحث أن تكون قلة الدراسات على رواية أرملة من الجليل –لغاية إجراء هذه الدراسة على الأقل- بسبب حداثتها، إذ إنها نُشرت في العام 2023م.
جاءت هذه الدراسة مقسمة في مقدمة تضمنت التمهيد لموضوع الدراسة وأهميتها ومنهجها والدراسات السابقة، ومبحثين تناول الباحث في المبحث الأول الجانب النظري للدراسة، ما بين مفهوم الزمن والرواية في اللغة والاصطلاح، وجاء المبحث الثاني (الجانب التطبيقي للدراسة) في مطلبين: غطى المطلب الأول الزمن الخارجي المتعلق بالرواية وما يلحق به، واشتمل المطلب الثاني معالجة أبعاد وتقنيات الزمن في النص الروائي، وعرض الشواهد المتعلقة، وتحليلها بما يؤدي الغرض من هذه الدراسة، ثم خاتمة لهذه الدراسة تضمنت أبرز نتائجها، وثبت المصادر والمراجع.
المبحث الأول: الجانب النظري، آثر الباحث الوقوف ولو بشيء يسير من التفصيل على أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمادة الدراسة، حتى تشكل نقطة انطلاق للمتلقي في إدراك الجوانب والمحاور الأخرى من هذه الدراسة، فكان هذا المبحث موزعاً على مطلبين تناولا مفهوم كل من الزمن والرواية في اللغة والاصطلاح.
المطلب الأول: مفهوم الزمن في اللغة والاصطلاح
أولاً: الزمن في اللغة: نجد مفهوم الزمن في لسان العرب تحت مادة (زمن) “زمن: الزمن والزمانُ: اسْم لِقلِيل الْوَقْت وَكثِيره، وَفي الْمُحْكَمِ: الزَّمن والزمان العصْر، والْجمْع أَزْمُن وأَزْمان وأَزْمِنة”[8] أما في القاموس المحيط فنجده يعني:” الزمن، محرَّكةً وكسَحابٍ: العَصْرُ، واسْمان لقَليل الوقْت وكثيره، ج: أزْمان وأزْمِنَة وأزْمُنٌ”[9]
ثانياً: الزمن في الاصطلاح: تباينت الآراء حول تحديد مفهوم الزمن ولو بشكل نسبي، وكانت في مجملها لا تخرج عن الإطار العام الذي تدور فيه هذه التعريفات والمفاهيم، ومن ذلك ما أورده عبدالملك مرتاض في تحديده لمفهوم الزمن بأنه: “مظهر وهمي يُزمْنِن الأحياء والأشياء فتتأثر بمضيه الوهمي، غير المرئي، غير المحسوس، والزمن كالأكسجين يعايشنا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من حركاتنا، غير أننا لا نُحس به، ولا نستطيع أن نتلمسه، ولا أن نراه، ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة له، وإنما نتوهم أو نتحقق، أننا نراه في غيرنا مجسدا: في شيب الإنسان وتجاعيد وجهه، وفي سقوط شعره، وتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره، واتِّباس جلده…”[10] وقد أثبت الباحث وأورد ما يتعلق بالزمن من ناحية المفهوم كونه أهم عناصر الرواية من جهة، وكونه المقصود بهذه الدراسة من جهة أخرى، علماً أن كثيراً من المختصين قد أسهبوا في الحديث عن مفهوم الزمن في هذا المجال، ولكن الباحث اكتفى بما أورده في هذا الجزء من الدراسة لعله يغني نوعا ما عن غيره من الشروحات التي لا تبتعد كثيراً عمَّا تحدث به مرتاض وإن اختلفت الجمل والتعبيرات.
المطلب الثاني: مفهوم الرواية
أولاً: الرواية في اللغة: إذا ما عدنا إلى معجم لسان العرب، نجد تعريف الرواية تحت مادة: (ر. و. ى) فيقال: “رويت القوم أرويتهم إذا سقيت لهم، ويقال: من أين ريتكم؟ أي من أين ترتوون الماء، ويقال: روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه”[11]
أما في المعجم الوسيط “روى على البعير ريا: استسقى، روى القوم عليهم ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعير، شد عليه بالرواء: أي شد عليه لئلا يسقط من ظهر البعير عند غلبة النوم، روى الحديث أو الشعر رواية أي حمله و نقله، فهو راوٍ (ج) رواة، وروى البعير الماء رواية حمله ونقله، ويقال روى عليه الكذب، أي كذب عليه وروى الحبل ريا: أي أنعم فلته، وروى الزرع أي سقاه، والراوي: راوي الحديث أو الشعر حامله وناقله، والرواية: القصة الطويلة”[12].
ويكتفي الباحث بهذه الإيرادات حول المفهوم اللغوي كونها تجتمع في الغالب حول نفس المضمون وإن اختلف التوصيف.
ثانياً: الرواية في الاصطلاح: أما إذا أردنا الوقوف على مفهوم الرواية اصطلاحاً، فإن الأمر يتسع اتساعا باهراً! فهو لم يستقر على حال، بل إن الكلام فيه ما زال ذو أطراف وتشعبات، ومن هذه التعريفات ما جاء في معجم المصطلحات الأدبية “الرواية سرد قصصي نثري يصور شخصيات فردية، من خلال سلسة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والرواية تشكيل أدبي جديد، لم تعرفه العصور الكلاسيكية الوسطى، نشأ مع البواكير الأولى لظهور الطبقة البرجوازية، وما صاحبها من تحرير الفرد من رقبة التبعات الشخصية”[13]، وبيَّن عبدالملك مرتاض عدم استقرار مفهوم مُحدد للرواية بقوله: ” تتخذ الرواية لنفسها ألف وجه، وترتدي هيئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل، مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا، ذلك لأننا نلفي الرواية تشترك مع الأجناس الأدبية الأخرى بمقدار ما تستميز عنها بخصائصها الحميمة، وأشكالها الصميمة”[14].ويرى الباحث أن تقييد الرواية في مصطلح علمي ونظري ثابت أمر صعب المنال! وإذا ما تم ذلك فإن هذا المفهوم سيكون قاصراً عن الإحاطة بهذا الفن الأدبي المستمر في الاتساع والتمدد؛ ذلك أن الرواية فيها من المرونة ما يجعلها تستوعب معظم مناحي الحياة الإنسانية وتصوراتها، وعكس هذه التصورات والقضايا والأحداث وحتى الأشخاص من خلال بناء روائي لا يقيده مفهوم بقدر ما يتفنن فيه الروائي.
المبحث الثاني: تشكيل الزمن في رواية (أرملة من الجليل) ما من شك أن الزمن أهم ركائز الرواية، وهو العنصر الذي يجمع باقي مفاصلها، ويؤلف بين أطرافها وبنيانها، وبالتالي فهو “يمثل محور الرواية وعمودها الفقري الذي يشد أجزاءها، كما هو محور الحياة ونسيجها، والرواية فن الحياة”[15] وبما أن هذه الدراسة متعلقة بعنصر الزمن في رواية (أرملة من الجليل)، فإنه سيتم التعرض لأشكال الزمن وتقنياته المتمثلة في الرواية، وبما يخدم موضوع الدراسة، ويؤدي الفائدة المرجوة منها.
المطلب الأول: الزمن الخارجي، وهذا الزمن عادة ما يقع خارج إطار الرواية، بمعنى أنه لا يكون من ضمن الأزمنة المكونة لأجزاء وأحداث الرواية الداخلية، بل هو منفك عنها، ويشتمل في مجمله ثلاثة أوجه:
أولاً: زمن الكتابة: ويقصد به “الزمن الذي أنشأ فيه الكاتب نصه، ويمكن النظر إلى زمن الكتابة في مستويين: عصر الكاتب الذي يؤطر حياة الكاتب في مختلف جوانبه الحضارية وتأثيرها في مجمل إنتاج كاتب أو جماعة أدبية، وفي المستوى الثاني يتصل المفهوم بمرحلة محددة من حياة الكاتب وبالفترة التي أُنتج فيها النص تحديداً”[16] وإذا ما تأملنا هذه الجوانب والمستويات المتعلقة بزمن كتابة رواية (أرملة من الجليل) سنجد الكثير من الأشياء التي لا يمكن إغفالها في هذه الجزئية، سواء كانت مرتبطة بالكاتب نفسه، أو ذات صلة بالحقبة الزمنية تلك، وما تخللها من أحداث وتغييرات، وهذا أمر واقع لا محالة، بل إنه لا مفر منه، وقد “نلاحظ أن الروائي يطمح لأن يكون سكرتير الحياة الخاصة”[17] بمعنى أن الكاتب سينتج نصاً –ولو بشكل نسبي- يكون انعكاسا عن بيئته أو حالته أو زمانه أو غير ذلك من العوامل المؤثرة فيه.
وبناء على ذلك، فإن زمن الكتابة الفعلي لا تحكمه مدة معينة “فقد يكون ساعات أو أياماً، وقد يمتد على شهور وسنوات مع انقطاعات ممكنة وإعادات للصياغة”[18] وهذا الزمن – زمن الكتابة – لم يرَ الباحث أي إشارات إليه في الرواية، وكأن الكاتب اكتفى بما أفرغه وأدرجه في نصه الفني.
ثانياً: الزمن التاريخي: ويُقصد بهذا الشكل أو النوع من الزمن “الذي يظهر في علاقة التخيل بالواقع”[19] بمعنى أن كاتب الرواية يستجلب الوقائع والاحداث والتغييرات التاريخية والاجتماعية والسياسية وغيرها على مختلف الصعد، ويوثقها في نصه الروائي بصورة جمالية، تجعل المتلقي والجمهور يلامس الحقيقة من خلالها، بل كأنه جزء من هذه التصورات والمشاهد، فتُبنى العلاقة بين شخوص الرواية والقارئ، وبالتالي “إن الراوي الأول الشاعر الذي يعلق السامعين بشفتيه، كما يقولون عليه، ليساوي بين السامعين وأبطاله أن يروي الحوادث بالتسلسل وفقا للزمن الذي جرت فيه، فيصبح الوقت الذي تستغرقه القصة كأنه اختصار للوقت الذي استغرقته المغامرة”[20] وهذا أمر ظهر جلياً للباحث في رواية (أرملة من الجليل) من خلال عرض لكثير من الأحداث والوقائع التاريخية بصور وأساليب متنوعة، تجعل القارئ يتفاعل مع هذه الأحداث وكأنه أحد عناصرها، بل كأنه يعايشها.
ومن ذلك ما أورده الكاتب من مشاهد تصور المواجهات بين الأهالي في إحدى القرى الفلسطينية والجنود الإسرائيليين “تقدم الجنود من منطقة البركة إلى أحياء القرية (حي البركة) ومن ثم حي (المُراح) و (باب الزاوية) وهم يمطرون المتظاهرين من الشباب بزخات الرصاص المتواصل …أما الشباب فلم يقفوا مكتوفي الأيدي بل أمطروا الجنود بوابل من الحجارة، وقد استمرت المطاردة الثنائية الكر والفر بين الجنود المقتحمين والشباب المدافعين إلى أن نفدت الذخيرة من الجنود فطلبوا من الشيوخ تهدئة الشباب حتى يتمكنوا من الانسحاب وهذا ما حدث“[21] ومن خلال هذا السرد التاريخي لهذا المشهد، وهذا الحدث الذي كنا نشاهده كثيراً على شاشات التلفاز – وما زلنا- أظهر الكاتب المعاناة الحقيقية، والمواجهات المؤلمة، ما بين صاحب أرض وحق، وعدو غاشم معتدي! يُصرُّ على أخذ ما ليس له.
ومن الطبيعي أن يكون إحدى مهام الكاتب في مثل هذه النتاجات الأدبية تتمثل بإظهار الواقع وبلورته بالصورة التي يراها بما يوازي التفاصيل الحقيقية في وقتها، ذلك “إن عمل كل روائي سواء كان يعالج وضعا معاصراً أو يقودنا إلى النأي عنه إلى برج عاجي، إنما هو تعليق ضمني أو صريح على الوقت الذي كتب فيه”[22] وهذا مما أجاد الكاتب في رسمه ورصفه في نصه الروائي.
وقد يقول قائل: وما فائدة هذا السرد وهذا التصوير لحدث تاريخي ربما يعرفه ويشاهده الكثير من الناس في الوقت الماضي أو الحاضر؟! بل قد لا يخفى على مُطَّلع! فيرى الباحث أن تصوير مثل هذه المشاهد على حقيقتها، وإقحامها في النص الروائي تُعد عملية توثيقية بالدرجة الأولى، ثم إنها تدمج القارئ في تفاصيل الحدث والواقعة وكأنه يعايشهما، وهذا أقرب وأدعى للتفاعل الوجداني من قبل كل مهتم، فكم من الجمهور اطلع على تفاصيل ما يحدث لأهلنا هناك من خلال هذه النصوص والكتابات والمشاهد والتصويرات، فالأمر لايُقيد بالتلفاز أو سماع الأخبار من هنا وهناك، لذلك كان مثل هذا العرض التاريخي ضروريا في النص الروائي، خاصة عندما تكون طبيعة الرواية أقرب للرواية التاريخية والسيرة الذاتية، مثل رواية (أرملة من الجليل)، ثُمَّ إن تصوير طرفي المواجهة وسلاح كل منهما أمر لم يغفل عنه الكاتب، ولك أن تقارن بين سلاح العدو وأدوات الشباب المقاومين المدافعين عن أرضهم.
لذلك، تظهر جماليات هذا السرد التاريخي والذي يندرج تحت الزمن التاريخي المتعلق بالنص الروائي، من خلال ما يحدثه من تفاعل واندماج لدى المتلقين – ونحن منهم- وما يضيفه إلى وجدان كل مهتم بتلك القضية.
وفي متابعة المشهد التاريخي والتوثيقي، وعلى إثر تلك المواجهات المتكررة، يوثق الكاتب لحدث هام، وتاريخ أهم، ويوم أشم، وهو يوم الأرض “في حوالي الساعة التاسعة من مساء التاسع والعشرين من آذار عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين سقط الشهيد الأول ليوم الأرض (جابر الطحان) في حي المُراح برصاص قناص“[23] ويلاحظ الباحث في هذا التصوير التاريخي، أن الكاتب أمعن في ذكر أدق التفاصيل في بعض سرده التاريخي، ففي النص السابق، ذكر الساعة واليوم والعام، وهذا مما يُبرز الحدث على حقيقته، ويؤكد أهميته، فلو كان حدثاً عاديا لما ذُكر بهذه التفاصيل، إذ إن سقوط الشهداء، بل أول شهيد في ذلك الحدث أمر جلل، وهو مما لا يهون على أحد، سواء رأى أو سمع أو قرأ، إضافة إلى أهمية ذلك اليوم وهو (يوم الأرض) الذي يُعبر عن كل معاني التضحيات والدفاع عن الأرض.
وما زال الباحث يجول في فلك الزمن التاريخي المتعلق بالرواية، وفي مشهد آخر في النص الروائي، يُظهر الكاتب مدى التلاحم بين الشعب الفلسطيني والجيش العربي خلال حرب عام 48 من خلال حديث والدته عليه، وقصِّها له لما كان في تلك الأيام “وقد قصت لي –أي والدته- ما كان يفعله الوالد لجنود جيش الإنقاذ، الجيش العربي الذي حارب اليهود في فلسطين خلال حرب عام 48، ومما ورد على لسانها أن الجنود كانوا يبيتون في الجبال خلف متاريسهم، وقد اعتاد الناس في كل قرية أن يعدوا لهم الطعام“[24] فالكاتب من خلال هذا الحدث التاريخي، وتأصيله على لسان والدته –وهي شاهد عيان-، يجعل القارئ يذهب بخياله إلى تلك الحقبة، ويتأمل مدى اللحمة التي كانت بين أهل الحق والأرض الشعب الفلسطيني في قراه ومدنه، مع الجيش العربي الذي هبَّ للذود عنهم، وكيف أن هذا الشعب قدم ما يستطيع من مؤنة ومعونة وغيرها مما يلزم جنود الجيش العربي في جميع مواقعهم.
ومن جهة أخرى، أظهر الكاتب من خلال قص أمه عليه، أهمية هذه الأحداث والتواريخ، بدليل أن أمه – كما باقي الأمهات- ما زالت تحدث أطفالها عن تلك الوقائع، ولم تنس حجم التضحيات التي بذلها الجيش العربي، ولم تُغفل حجم المعونة التي قدمها أهل القرى لذلك الجيش، وهذا الأمر بطبيعة الحال ستُحدِّث به وترويه الأجيال القادمة، ومثل هذا السرد التاريخي يرى الباحث أنه يزيد الأمر واقعية وقبولا، بل يجعل المتلقي يتمنى أن لو كان معهم وبينهم!
ثالثاً: زمن القراءة: أمّا زمن القراءة فإنه “يتضمن دلالتين: زمن القراءة الفعلي وعصر القراءة، فالأول هو الذي يحتاج إليه القارئ المفرد لقراءة النص، وهو لذلك غير محدد تحديدا دقيقا بالنظر إلى اختلاف تجارب القراءة وتفاوت القراء من حيث السن والثقافة والمقصد… والبعد الثاني يتصل بعدد القراء والقراءات واختلاف العصور والثقافات، فالنص قد يظل مقروءا زمنا طويلا بعد وفاة مؤلفه، فيخرج من زمن إلى آخر، ومن محيط ثقافي إلى محيط مغاير، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف القراءات في عصر الكاتب وفي ما بعده”[25] وفيما يتعلق بزمن القراءة الفعلي لرواية (أرملة من الجليل) فإنه لا يمكن تحديد أو تقييد هذا الزمن، وذلك بسبب الفروقات الطبيعية والنسبية بين مجتمع القراء والمتلقين، فلا يُعقل أن يقرأها الإنسان المُتبحر المُتمكن كما يقرأها من هو دون ذلك، أيضاً لا يتساوى في قراءتها كل من قرأها للتسلية أو قراها للتفحص والإمعان أو الاطلاع على طبيعة المرحلة الزمنية وأحداثها، أو زيادة معرفته وثقافته بتاريخ ذلك الشعب أو الأمَّة في مرحلة من مراحلها.
أما من جهة عصر القراءة المتعلق برواية (أرملة من الجليل) فإنه بدأ من لحظة نشرها وإعلانها لجمهور القراء، أي عام 2023م، وبذلك يكون هذا النص الروائي قد انتقل من ملكية كاتبه ومؤلفه ومبدعه، إلى متناول المجتمع المهتم بهذا اللون الفني أو بمحتواه، وأصبحت الرواية منذ ذلك الوقت في متناول الجميع، بغض النظر عن صنوفهم واهتماماتهم وثقافاتهم ومواقعهم – ونحن منهم- بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، بمعنى أن هذا النص الأدبي سيمر على عصور وأزمنة مختلفة تلي عصر إنتاجها دون قيود للزمان أو حتى المكان، وإنه قد تأتي أجيال أخرى وتتناول رواية (أرملة من الجليل) ربما بغير الطريقة والبعد اللذين كانا في عصرها، وهذا أمر لا مفر منه، وهو جار على كل نتاج أدبي فني وقع بين أيدي الناس، واقتحم آفاقهم، وتُقبِّل في وجدانهم، بغض النظر عن مدى تفاعلهم أو تشربهم لهذه الرواية أو تلك، أو هذا النتاج الأدبي عموما أو ذاك.
المطلب الثاني: الزمن الداخلي: وهذا الشكل من أشكال الزمن يتمحور ويُبنى ضمن الإطار العام داخل الرواية، حيث يقوم المؤلف ببناء وتأليف جميع محطاته السردية في الرواية من خلال الخيوط الرفيعة لهذا الزمن، لذلك فإن “طريقة بناء الزمن في النص الروائي تكشف تشكل بنية النص، والتقنيات المستخدمة في البناء، وبالتالي يرتبط شكل النص الروائي ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن”[26] ومن الطبيعي بمكان، أن لا يتأتى هذا الربط الروائي من خلال الزمن في جسم الرواية إلا من خلال تقنيات متعلقة بهذا الجانب، والتي قد تختلف درجة اتقانها وتوظيفها من نص إلى آخر، وهذه التقنيات تخلق ما يُسمى بالترتيب الزمني الذي يقوم على مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو الوقائع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع فيه الأحداث والوقائع الزمنية نفسها في الرواية أو تتقاطع وتتشابك، وبالتالي فإن “زمن القصة يخضع للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي”[27] وقد وقفت الدراسة على أهم التقنيات التي استُخدمت ضمن هذا الإطار، وإظهارها في رواية (أرملة من الجليل)، وإثبات ما يلزم من شواهد تتعلق بكل تقنية منها، وبما يُظهر تجليات الزمن الداخلي ومتعلقاته وتقنياته في النص الروائي.
- القطع (الحذف) (الإسقاط): وهو “تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث”[28] ومثل هذه التقنية لا تكاد تخلو رواية منها، بل إن معظم كُتَّاب الروايات قد يتمايزوا في توظيف مثل هذه التقنية في نصوصهم، أما الغاية منها فإنه “يلتجئ الروائيون التقليديون في كثير من الأحيان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة إليها”[29] وقد استعمل كاتب رواية (أرملة من الجليل) هذه التقنية في روايته، وظهرت جلية بائنة في عدة مواضع من النص الروائي، ومن ذلك: “أمي صديقة الأمراض منذ سنوات لقد فقدت إحدى كليتيها بعد استئصالها بعملية جراحية“[30] يلاحظ الباحث في هذا النص الروائي، كيف تجاوز الكاتب ذكر عدة أمور، وهذا يندرج تحت تقنية القطع، فلم يذكر أو يحدد عدد تلك السنوات التي مرت على فقدان والدته كليتها، وهذه مدة زمنية قد تكون طويلة أو قصيرة، ولم يذكر ما هي الأمراض التي كانت تعاني منها غير ما يتعلق بالكلى، ولكن الكاتب أسقط هذه التفاصيل، واكتفى بما ذكره من إشارات، وهذه تقنية تبرز كثيراً في النص الروائي أو القصصي، وقد يحتاج إليها الكاتب لتسريع الحكي والسرد، أو لعدم أهميتها من ناحية التفاصيل التي لا تتعلق بمضمون النص الروائي أو مناسبته عموما.
ومن الشواهد التي رصدها الباحث في النص الروائي، والتي تبرز تقنية القطع “لما قطعت مشواراً من عمري وصرت متمكناً بقدر ما من فلسفة المواقف والتصرفات، أدركت أن السعادة تكمن في تفاصيل الأيام والزمان، وهي ليست مرحلة ثابتة في مكان ما أو مرحلة معينة من الزمن“[31] في هذا الجزء من الرواية، أورد الكاتب في النص حديثا عن المشوار الذي قضاه من عمره حتى أصبح متمكناً، فلم يحدد أو يعيِّن هذه المدة من العمر، أو كم كان عمره حين أدرك ذلك، ولم يتطرق لتفسير الفلسفة أو المواقف أو التصرفات التي يعنيها، وأيضا لم يوضح مقصوده بالسعادة وفي أي جانب تكون، جميع هذه التساؤلات كان بإمكان الكاتب أن يدرج ويقحم تفاصيلها وأجوبتها في نصه الروائي! لكن آثر توظيف تقنية الحذف أو القطع في مثل هذه الجزئيات، مما زاد النص متانة وقوة، وعدم التفاته لبعض التفصيلات التي قد تشغل المتلقي عن الفكرة الرئيسية والجوهرية، أو قد يكون الأمر غير ذلك، فقد يكون من باب ترك التفسير للقارئ وإشراكه في النص الروائي بحسب ما يذهب به اعتقاده.
ويلاحظ الباحث أن ملامح هذه التقنية (القطع) قد تتقاطع أحياناً وتتشابك مع ما يُسمى (الثغرة الزمنية) وهي أيضاً من الأمور المتعلقة بالزمن في الرواية، وقد تكون هذه الثغرة الزمنية ضمنية يقدرها المتلقي، أو معلنة يُصرح فيها الكاتب بمقدار تلك المدة الزمنية التي لا يعالجها في زمنه الروائي.
- الاسترجاع: قد يلجأ الكاتب في روايته إلى العودة إلى بعض الأحداث أو الوقائع أو ما شابه مما كان في الماضي أو التاريخ السابق، وهذا يندرج تحت ما يُعرف بالاسترجاع أو الفلاش باك وهو “مصطلح روائي حديث، يعني: الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب… وهو تقنية زمنية تعني أن يتوقف الراوي عن متابعة الأحداث الواقعة في حاضر السرد، ليعود إلى الوراء مسترجعا ذكريات الأحداث والشخصيات الواقعة قبل أو بعد بداية الرواية”[32].
وفي رواية (أرملة من الجليل) يجد الباحث العديد من الشواهد والمشاهد التي احتوت على تقنية الاسترجاع هذه، فعلا سبيل المثال: “ما أروعه، كان صاحب فراسة أبوية معجونة بالحنية وعليه دائما عرف متى يجب عليه أن يدس في جيوبنا مصروفا، ناهيك عن رعايته المعنوية والمادية الأخرى لجميع أفراد العائلة، إنه عامود البيت لبيت قد انفقد عاموده، عمي حنون جدا لم يغفل عن واجبه الإنساني تجاهنا يوما ما“[33] يلاحظ الباحث كيف بنى الكاتب هذا الاسترجاع في نصه الروائي، وعاد إلى أحداث أو تفاصيل لا تتعلق بالسياق الحالي والحاضر للسرد، بل إنه عاد بالقارئ ما قبل أحداث الرواية! وهذا ما يُسمى بالاسترجاع الخارجي الذي فيه “يرجع الراوي إلى الوراء كثيرا ليسرد أحداثاً سابقة لبداية الرواية”[34] فحديثه هذا كان عن عمه الذي ذكره بجميع صفاته السابقة، ووقوفه إلى جانب عائلته، وهي عائلة الأرملة التي مات زوجها، وما لازم ذلك من رعاية وقضاء حوائج واهتمام…، جميع هذه التفاصيل عاد إليها الكاتب وأعاد القارئ إليها، وبالتالي رسم المشهد، وأكمله وأجاب عن تساؤلات قد تتبادر إلى أذهان المتلقين، من ناحية وقوف الأعمام إلى جانب عائلة أخيهم المُتَوفَّى.
ومن الاسترجاعات التي وقف عليها الباحث في النص الروائي، ما أورده الكاتب في حديثه عن زواج أمه بأبيه وظروف هذا الزواج: “أمي من قرية سخنين المجاورة لقريتنا، تزوجت من والدي بالأسلوب التقليدي في ذاك الزمان، أبي لم يرها ولم يعرفها من قبل، بل إن شخصا من القرية كان صديقا لوالدها رآها وهي تقدم العلف للماشية في بيتهم… فاستحسنها واعجب بشخصها وحيائها وعندما عاد إلى القرية اختار لها عريسا يستحقها وهو والدي“[35] ويلاحظ الباحث من خلال هذا الاسترجاع في النص، كيف عاد المؤلف إلى حقبة بعيدة جداً، وهي فترة زواج والديه، وكيف وصف الطريقة والأسباب التي كانت سبب لزواجهما، هذه العودة للوراء استحضرها المؤلف خلال سرده القصصي، دون تشابك في الأحداث، أو خلل في بناء الرواية، ولكنها استرجاعات يلجأ إليها المؤلف في روايته لأسباب قد تظهر للقارئ، أو لا تظهر، وهذا أمر على تماس مباشر بما يُسمى بالزمن السردي، فقد قطع الزمن الحاضر ليعود إلى الزمن الماضي، وهذا أمر لا شك أن له وقعه على المتلقي، وبحسب استيعابه لأحداث الرواية.
وعن جماليات هذه التقنية، وأثرها في النص الروائي فهي “من أكثر التقنيات الزمنية السردية حضورا وتجليا في النص الروائي، فهو ذاكرة النص، ومن خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ينقطع زمن السرد الحاضر ويستدعي الماضي بجميع مراحله ويوظفه في الحاضر السردي فيصبح جزءا لا يتجزأ من نسيجه”[36] والمؤلف من خلال هذه التقنيات بما فيها الاسترجاع يُكسب النص الروائي تنوعا جميلاً، يجعله يبعد القارئ عن الملل أو فقدان التشويق، وهذان أمران غير مستحبان في تناول الأعمال الفنية الأدبية عموما.
- التلخيص: تقنية التلخيص أو الخلاصة تُضاف إلى التقنيات الأخرى السابقة واللاحقة، وهي حاضرة في الرواية، لذلك “نتحدث عن التلخيص أو الخلاصة كتقنية زمنية عندما تكون وحدة من زمن القصة تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة المعروضة”[37] ولهذه التقنية أثر كبير في تسريع السرد، وتجاوز بعض المحطات التي لا تلزم الكاتب في نصه الروائي، “وتكون هذه العودة التلخيصية إلى الماضي كثيرة التواتر في بداية الروايات فتقوم بسد الثغرات الحكائية التي خلفها السرد وراءه عن طريق امداد القارئ بمعلومات حول ماضي الشخصيات والأحداث التي شاركت فيها”[38] وكما هي التقنيات الزمنية السابقة، جاءت تقنية التلخيص بقوة في رواية (أرملة من الجليل) واستعملها الكاتب في مواضع عدة من روايته، ومن الشواهد التي التقطها الباحث في النص الروائي وتمثلت فيها هذه التقنية: “طعم الحزن المخيم على الوالدة، المنعكس على أفراد الأسرة المتماهية معها، سعادة مغموسة بالحسرة، يا له من طعم خاص“[39] إن القارئ والمتلقي لمجرد تفاعله مع هذه العبارات، واستشعاره للموقف، وتخيله للمشهد، ليشعر بكمية الألم القديم الجديد، والحزن العميق الذي يختلج صدر تلك الأرملة، ويعتصر قلبها، تلك الأم، الأم الأرملة المقصودة في الكلام، إضافة إلى تأثير ذلك على باقي أفراد العائلة.
ويرى الباحث كمية المشاعر والأحاسيس والعواطف التي لخصها المؤلف في هذه العبارات والكلمات، ولو أراد الإفصاح عنها، أو التعبير بالقدر الحقيقي، لاحتاج لجزء غير قليل من سطور النص الروائي، وهنا تتجلى تقنية التلخيص، وكيف استثمرها المؤلف لاستجماع كثير من التفصيلات في عبارات مركزة محددة أغنت عن ذلك التفصيل، ولم تؤثر على النص الروائي سلبا في نفس الوقت.
ومن الشواهد التي ظهرت فيها هذه التقنية: “صمت، صمت مدقع، بل صمت المقابر، الناس نيام لا أحد يحرك ساكنا، لا باب بيت يفتح ولا نافذة، كأني في مكان من بلاد العجائب وقد دخلها السحرة، وفعلوا ما فعلوا بالسكان حتى أبقوهم في سبات عميق“[40] فالمؤلف خلال هذا الجزء من النص الروائي يُحاول إظهار تلك الحالة للناس أو الحي أو القرية، وكيف يصفهم وكأنهم أموات! فالميت لا تُرجى حركته، إضافة إلى أن هذا المشهد هو في الأصل جزء من الحلم وليس الواقع، ومع ذلك أراد المؤلف تلخيص كثير من المعلومات والأحداث والسرد الحكائي في هذا الجزء من النص، ليوصل للمتلقي حالة الركود والصمت آنذاك، وبالتالي استعمل العبارات الدالة على هذه الحالة، والتي قد أدت في مضمونها ومعناها كثير من المعاني المعبرة عما يريد المؤلف إيصاله من خلال النص، وهذا مما يندرج تحت تقنية التلخيص، وهي لا شك لها الأثر الكبير في إعادة القارئ إلى الماضي القريب أو البعيد، وتصوير بعض أحداثه ومجرياته بأقل ما يمكن من التعبيرات.
- المشهد: أَمَّا المشهد، وهو تقنية أخرى من التقنيات الدارجة في الرواية، بل في أي رواية، فيكون: “بتزامن الحدث والنص حيث نرى الشخصيات وهي تتحرك وتمشي وتتكلم وتتصارع وتفكر وتحلم”[41] إذا فهو تصوير تمثيلي يدرجه الكاتب أو المؤلف في نصه الروائي، يُسلط من خلاله الأنظار على تفاصيل وجزئيات يلمسها المتلقي ويلحظها، بل ويراها وكأنها واقعة الآن، ومن جهة أخرى فإن “لحظة المشهد الحواري الذي يرد في أثناء السرد تُعتبر نموذجا لتطابق الزمنين، وحالة قصوى من تعادل القول مع الفعل”[42] وإذا ما أتينا إلى رواية (أرملة من الجليل) نجد احتوائها على العديد من المشاهد التي تُبرز هذه التقنية، وتؤدي أغراضها وفوائدها على المتلقي أو النص الروائي.
فمن هذه المشاهد: “بعد ثلث ساعة تنبهت أن الطبيب غارق بما تقوله أمي، مسرور جداً وقد غفل عن سبب زيارتها له فتدخلت لأقطع عليهما الحديث وأشرع بطرح حالة الوالدة الصحية، تنبه الطبيب وبابتسامة منه قال مازحا: من يملك ذاكرة وقوة حديث مثل الخالة (أم وفيق) وهي أمي فلا يمكن أن يكون مريضا! فشكرناه على هذه اللفتة الجميلة…”[43] ففي هذا المشهد يُلاحظ الحوار الدائر بين أطراف المشهد، وكأنهم جالسين أمام القارئ يستمع لهم، فيرى الأم الأرملة وهي جالسة تشرح للطبيب وتُسهب في الحديث، ويرى ويسمع مداخلة الأبن لينبه الطبيب إلى سبب الزيارة، وفي المقابل رد الطبيب الذي يحاول رفع معنويات الأم الأرملة المريضة المرهقة، فيداعبها بكلمات لطيفة لعلها تُنسيها مرارة الألم، وشدة الوجع، وتتمالك نفسها، هذا المشهد بحواره وأطرافه وشخصياته وتفاعلاته وتفصيلاته الدقيقة، يجعل المتلقي يتعايش معه ثم يندمج فيه، وكأنه واقع أمامه، أو شاهد عيان عليه، وهذا من جماليات هذه التقنية التي استعملها المؤلف في نصه الروائي، الأمر الذي كان له الأثر اللطيف، والملمس الأنيق.
ومن المشاهد الأخرى التي رصدها الباحث أيضاً: “كانت الليلة الثانية في بيت الوالدة، لم أغادر البلدة بل آثرت البقاء عندها ليوم إضافي، نفس الغرفة وذات السرير… آه يا حاجة يلا احكيلي …شو بدي أحكي يما؟ مش عارفة … وبدأت أمي تسرد لي حكايا من فترة الفلاحة في سهل البطوف“[44] ففي هذا المشهد التصويري، لك أن تتخيل (محمد) وقد جاور والدته الأرملة عند سريرها في تلك الليلة! وكيف استلطفها واستجرها بأسلوبه اللطيف، وتبادلا أطراف الحديث حتى بدأت الأم بسرد تلك الحكايا القديمة على محمد، هذه الأم بطبيعة الحال لن تأتي بقصص من الخيال! بل ستعود بذاكرتها إلى الوراء مستحضرة تلك الأحداث على اختلافها، وبما تتسع له ذاكرتها، وبالتالي ستمر تلك الليلة على هذا المنوال والوقع، وهذا مشهد مكتمل الأركان، استطاع المؤلف أن يصوره ويؤلفه للقارئ، وينسجه ضمن أجزاء النص الروائي، فيزيده قوة ومنعة ومتانة، ويوسع مدارك المتلقي لاستيعاب أحداث جمة، وتفاصيل كثيرة، ليتم رصفها جميعا، وتكون مشهداً آخر يُضاف إلى مشاهد النص.
ويلاحظ الباحث في هذه التقنية (المشهد) أن معظم المشاهد التي أوردها الكاتب في روايته متعلقة بوالدته الأرملة، وهذا بحسب ما يرى الباحث أمر طبيعي نوعاً ما؛ إذ إن هذه الأرملة والوالدة هي محور الحديث، وهي الشاهد العيان على كثير من أحداث ووقائع الرواية، ثمَّ إنها أصبحت مثالاً للتضحية والصبر والصمود، وسدِّ الفراغ الذي تركه الأب بعد وفاته.
- الاستباق: ومن التقنيات المتعلقة بالزمن الروائي أيضاً (الاستباق) حيث يُعرِّفه أحمد النعيمي بأنه: “الولوج إلى المستقبل، إنه رؤية الهدف أو ملامحه قبل الوصول الفعلي إليه، أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليها”[45] وهذه التقنية إذا، تقوم على استجلاب الحدث في السرد الروائي قبل أوانه، أو بعض ملامحه ومتعلقاته أو حتى الإشارة إليه، وقد يكون لغايات فنية أو لتحقيق فوائد أخرى يراها المؤلف، ومن مترادفات هذا المصطلح (الاستشراف والاستقبال) فقد “يستعمل مفهوم السرد الاستشرافي للدلالة على كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداثا سابقة عن أوانها أو يمكن توقع حدوثها، ويقضي هذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث، أي القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في الرواية”[46] وعودة إلى روايتنا موضع الدراسة، وخلال التبحر في أجزائها ومقاطعها وأحداثها، يجد الباحث القليل من الاستباقات أوالاستشرافات في النص الروائي.
فمثلاً: “أمي كسائر النساء الأرامل في ذاك الزمان، لما ابتلاها الله بالترمل وهي في بهاء الثلاثين تصالحت مع الزمن ورضيت بما قدر الله وقسم، صارت صديقة للحزن تروضه أحيانا ويصرعها حيناً، لكن رسالتها الإنسانية غلبت الحزن رغم تجذره“[47] وقد لمس الباحث في هذا الجزء من النص الروائي وفي حديث (محمد) عن والدته الأرملة، كيف استشرف الأحداث واستبقها في روايته، فهو يصور مفاصل كثيرة، ومحطات متنوعة من حياة والدته الأرملة الصابرة المرابطة، والتي قد فات وجرى بعضها، لكن قسماً من هذه الأحداث والمحطات لم يأتِ –خلال موضع هذا الاستباق – في النص الروائي، ومن ذلك تصويره لكثرة الأحزان وشدتها التي صاحبت أمه في محطات حياتها المتتابعة، أيضاً أهدافها ومقاصدها في تربية أبنائها وتنشأتهم النشأة الصالحة القويمة، وثباتها وجلدها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها وبجميع الناس في مجتمعها، ومع ذلك فإنها كما عبَّر (محمد) في النهاية تغلبت وسيطرت على الصعاب والأحزان المتجذرة في حياتها، فتغلب هذه الأرملة على تلك الصعاب والأحزان وما يمر بها في محطات حياتها هي مرحلة متأخرة في نهايات قصتها، وإن بدت ملامح صبرها وجلدها خلال محطات حياتها.
ومثل هذا الاستباق في الرواية، يجعل القارئ يستشعر ويلمح بعض النتائج أو النهايات، أو حتى يتيقن منها، فيصبح يتهيأ لحدوثها كونه امتلك الأرضية الذهنية لتصورها من خلال تفنن المؤلف وتوظيفه لهذه التقنية العجيبة، فيعلم القارئ مسبقاً أن الأم الأرملة لن تيأس أو تضعف أو تتغير توجهاتها، قبل أن يصل المؤلف في سرده إلى التصريح بذلك أو عرضه في نصه الروائي.
ويلاحظ الباحث أن توظيف الكاتب لتقنية الاستباق في نصه الروائي كان بشكل ضئيل جداً، وقد يعود ذلك إلى طبيعة الرواية التي اعتمدت في نصها شكل السيرة الذاتية، أو الرواية التاريخية.
- الـوقفـة الوصفية (الاستراحة): وتكون هذه التقنية من خلال “توقفات معينة يحدثها الراوي في مسار السرد الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها”[48] ومثل هذه التقنية لا يكاد يخلو منها نص روائي، ذلك أن المؤلف لا يمكن إلا أن تلزمه هذه الوقفات أو الاستراحات المعتمدة على الوصف، وبالتالي فإنها “تشكل بظهورها في النص وفي جميع الوجوه والحالات توقفاً للسرد أو على الأقل إبطاء لوتيرته، مما يترتب عنه خلل في الإيقاع الزمني للسرد، ويحمله على مراوحة مكانه وانتظار أن يفرغ الوصف من مهمته لكي يستأنف مساره المعتاد”[49].
هذه الوقفات الوصفية أو الاستراحات، مما ظهر جلياً للباحث في رواية (أرملة من الجليل) فقد أمعن الكاتب في تشكيلها ورسمها في نصه، ومن ذلك: “لقد تبين الآن صاحبا الصراخ على ضوء المصباح الشحيح المنعكس على وجهيهما، إنهما زهرة وأسماء الطحان، فتاتان تجاوزتا الثلاثين من عمريهما، وجهان قمحيان شاحبان، تلبسان جلبابين ملونين، حافيتي القدمين، وقد تشققت تلك الأقدام بفعل العمل في الأرض وفلاحتها، كانتا قد اجتازتا الشارع الإسفلت المهترئ الذي يفصل حاكورة بيت الأرملة عن بيتهما، مهرولتين تطلبان حذائين (حفايتين) ولا أحد يعلم لماذا أرادتا حفايتين؟”[50] وهنا يقف المؤلف بل ويستريح! ليصف للقارئ والمتلقي هذا الحدث وصفاً لا يكاد يترك شيئاً فيه، فالحديث هنا عن الفتاتين وهما أخوات (جابر الطحان) بعد استشهاده برصاص قوات الاحتلال، ولكن المؤلف أوقف السرد الروائي بل وعطله، وأمعن في وصف هاتين الفتاتين، فابتدأ بالأعمار والأسماء وانتهى بالأقدام والأحذية! مرورا بملامح الوجهين، والجلابيب، ذاكراً أسباب تشقق الأقدام، بل وذكر تقارب المنزلين، وحالة الإسفلت أو الشارع، جميع هذه التفاصيل والأوصاف هي دلالات على الوضع الصعب، وحالة الهلع والخوف، ومرارة الأيام التي تتجرعها هاتين الفتاتين كما هي حال الكثير من الأهالي في ذلك الوقت، لكن ما يعنينا في هذا السياق هو كيف استوقفنا المؤلف، وحط رحاله، ونعيش هذه التفاصيل والجزئيات دون أن نشعر، وبالتالي انقطعنا عن السرد برهة من الزمن، وهذا مما يندرج تحت تقنية الوقفة الوصفية، وهي تقنية لها أبعادها الفنية في النص الروائي وأثرها على المتلقي.
ويرى الباحث أن مثل هذه الوقفات الوصفية لا تكون عبثاً في رواية (أرملة من الجليل) وإن كانت الأرملة هي محور الحكي والقص، لكن مثل هذه الوقفة الوصفية تشعر المتلقي بحجم المعاناة والألم وما يرافق ذلك من ظروف يعيشها ذلك المجتمع في وجود الاحتلال والظلم، وبالتالي يشعر المتلقي بحجم الصبر عند تلك الأرملة كما هي الحال باقي الأرامل أو النساء في تلك الحقبة.
ووقفة وصفية أخرى استراح عندها الباحث ملياً: “تصل إلى مصلاها بعد عشر دقائق وهي تنقر بالعكاز على البلاط القديم، وتجر رجليها جرا، حركاتها تصدر صوتا يمتزج بأنينها ولجاجها، هذا الصوت لا يمكن أن يمَّحي من مخيلتي أبداً، أشبه بلحن أو قل إيقاع جميل عميق راسخ في الوجدان، إيقاع يضفي معنى للبيت القديم، يعلن للساكنين فيه أن الفجر قد بزغ يوقظ النائمين بسلاسة وخفة، إيقاع يعني أن عجوزاً تسكن في هذا البيت وأي عجوز، تفرغ من صلاتها، أساعدها في مضغ بعض اللقيمات مع همهماتها المتقطعة، تطمئن لقيامها بواجبها الديني، فقد أدت صلاة الفجر على مصلاها وهو السرير“[51] ففي هذه الوقفة الوصفية الطويلة نوعا ما! استوقف المؤلف القارئ ليضعه ضمن الوصف العام، والجو الطبيعي والحقيقي لصلاة الأم (الأرملة) وهي في مراحل عمرها المتقدمة والمتأخرة، وقد أصابها ما أصابها من الأمراض والضعف والعجز، فأصحبت تسير على عكاز، وتصلي على السرير، وكل ما أصابها لم يمنعها من آداء فرضها وصلاتها! هذه التفاصيل في هذه الوقفة، تجعل المتلقي يقف احتراماً وتقديراً لسيرة أرملة الجليل، بل يُحدِّثُ بها وكأنها مثل للصمود والقوة والثبات! فهي بكامل قوتها الروحية، وذروة ضعفها الجسدي، ومع ذلك تؤدي فرضها وفجرها، بعدما أدت ما عليها تجاه عائلتها وأبناءها الأيتام، وهذا مما قد يعجز عنه بعض الرجال.
إذاً، فإن هذا الوصف المطول نوعا ما، والذي يكون بمثابة استراحة، أحدث التوقف في السرد أو أبطأ وتيرته، وهو أمر واقع لا تكاد تخلو منه رواية أو حتى قصة، وبالتالي فقد ظهر جلياً من خلال ما استعرضه الباحث من وقفات وصفية في الرواية، إضافة إلى كثير منها مما لا يتسع المجال لحصره.
وقد باين الكاتب في وقفاته الوصفية المختلفة ونوع فيها؛ فمنها ما هو متعلق بوالدته الأرملة، ومنها ما هو متعلق ببعض الأحداث والوقائع أو أجزائها… ولكنها وقفات أوجدت أثراً إلى حدٍ ما على المتلقي المتابع.
الخاتمة: وقف الباحث خلال إجراء هذه الدراسة على مشاهد وشواهد عديدة في رواية (أرملة من الجليل)، والتي تمثل تجليات الزمن وتشكيله من قبل المؤلف، ومعظم ما يتعلق بالبعد الزمني في الرواية، وقد حاول الباحث من خلال هذا العرض الإحاطة بهذه التقنيات بما يحقق الفائدة المرجوة من الدراسة، والغاية المرادة منها.
ومثل هذا العمل الأدبي يُعد غاية في الأهمية، إذ إنه توثيق حقيقي لفترة زمنية، وأحداث متكررة، ما زال الشعب الفلسطيني يعيشها، وليست حَصراً على المؤلف أو الأرملة أو عائلتها أو قريتهم أو مدينتهم الجليل، الأمر الذي جعل الرواية تكتسب الطابع التاريخي من جهة، وطابع السيرة الذاتية من جهة أخرى، فاستطاع المؤلف من خلال العديد من التقنيات المتعلقة بالزمن أن يُبرز كثير من التصويرات للأحداث والوقائع والمعاناة وغيرها، الأمر الذي أكسب الرواية أهمية وجمالاً فنياً، امتد تأثيره إلى شريحة القراء الذين يندمجوا في النص لمجرد تصفح الرواية وتأمل مفاصلها.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها:
- الرواية فن أدبي واسع وممتد، وقادر على استيعاب ظروف الحياة وعقدها ومحطاتها وأحداثها.
- تطورت الرواية العربية الحديثة حتى أصبحت تُضاهي الروايات العالمية فنياً وضمنياً.
- رواية (أرملة من الجليل) تُعد أنموذجا -لا يمكن إنكاره- معاشاً للواقع، وحتى يومنا الحاضر، إذ إنها تمثل جوانب معاناة الشعب الفلسطيني في مدنه وقراه.
- اكتست رواية (أرملة من الجليل) بطابع السيرة الذاتية، كونها تُجمل كثير من التفاصيل والأحداث الحقيقية التي مر بها المؤلف وأمه الأرملة وعائلتها وقريتهم ومدينتهم الجليل.
- غلب على رواية (أرملة من الجليل) السرد التاريخي بوقوفها على كثير من الأحداث التاريخية الماثلة في الذاكرة، مثل يوم الأرض.
- كان البعد الزمني حاضراً في النص الروائي، وله الكثير من الشواهد والمشاهد المختلفة.
- تضمنت الرواية عددا من المشاهد التي تمثل الزمن التاريخي.
- استخدم المؤلف تقنيات الزمن الداخلي المختلفة: القطع والاسترجاع والمشهد والتلخيص والوقفة الوصفية، وبما يحقق القوة والمتانة للنص الروائي، ويترك الأثر لدى المتلقي.
- ظهرت تقنية الاستباق بشكل قليل جدا في النص الروائي، وذلك بسبب اكتساب الرواية طابع السيرة الذاتية أو التاريخية.
- تُشكل رواية (أرملة من الجليل) مادة خصبة لمزيد من الدراسات المختلفة والمتنوعة الأخرى، إضافة إلى احتوائها كثير من المعرفة التاريخية الحقيقية المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
المصادر والمراجع
- إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، ط2، 1972.
- ابن منظور، لسان العرب، تح: اليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، ط3، 1993.
- إيان، واط، نشوء الرواية، تر: ثائر ديب، دار شرقيات، القاهرة، ط1، 1997.
- بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1990.
- بكرية، محمد ياسين، أرملة من الجليل، دار يافا العلمية الحديثة، عمان، ط1، 2024.
- الحازمي، حسن، البناء الفني في الرواية، دار النابغة للطبع والنشر والتوزيع، ط1، 2003.
- دراج، فيصل، الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2004.
- الربيحات، عمر أحمد، الشاعر وذاكرة الطفل في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، عمان، 2011.
- عبد الله، محمد حسن، الريف في الرواية العربية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998.
- فتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، ط1، 1986.
- فضل، صلاح، أساليب السرد في الرواية العربية، دار المدى للثقافة والنشر، ط1، 2003.
- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 2005.
- قاسم، سيزا، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، عمان، ط1، 2004.
- القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، ط1، 2010.
- القصراوي، مها، الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2004.
- لحمداني، حميد، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1991.
- لوكاتش، جورج، نظرية الرواية، تر: نزيه الشوفي، دمشق، 1987.
- مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998.
- مندولا، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط1، 1997.
- ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة-باريس، ط1، 1987.
- ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، دار عويدات، بيروت-باريس، ط3، 1986.
- النعيمي، أحمد، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2004.
- يوسف، آمنة، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط2، 2015.
المجلات والدوريات
- مجلة مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية، الجزائر، العدد السابع – جوان 2020.
[1] إيان، واط، نشوء الرواية، تر: ثائر ديب، دار شرقيات، القاهرة، 1997، ط1، ص18.
[2] ميخائيل، باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة-باريس، 1987، ط1، ص88.
[3] الربيحات، عمر أحمد، الشاعر وذاكرة الطفل في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، عمان، 2011، ص226-227.
[4]دراج، فيصل، الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2004، ط1، ص6.
[5] عبد الله، محمد حسن، الريف في الرواية العربية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998، ص200.
[6] الربيحات، عمر أحمد، الشاعر وذاكرة الطفل في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، عمان، 2011، ص9.
[7] نُشرت هذه الدراسة في: مجلة مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية، الجزائر، العدد السابع – جوان 2020، ص190-103.
[8] ابن منظور، لسان العرب، تح: اليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، 1993، ط3، 13\199.
[9] الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2005، ط8، ص1203.
[10] مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998، ص172-173.
[11] ابن منظور، لسان العرب، تح: اليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، 1993، ط3، 14\285 .
[12] إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، 1972، ط2، 1\384.
[13] فتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، 1986، ط1، ص60.
[14] مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998، ص11.
[15] القصراوي، مها، الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ط1، ص36.
[16] القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، 2010، ط1، ص237 (بتصرف).
[17]لوكاتش، جورج، نظرية الرواية، ترجمة: نزيه الشوفي، دمشق، 1987، ص 50.
[18] القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، 2010، ط1، ص237.
[19] بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ط1، ص114.
[20] ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، دار عويدات، بيروت-باريس، 1986، ط3، ص96-97.
[21] الرواية: ص25.
[22]مندولا، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، دار صادر، بيروت، 1997، ط1، ص104.
[23] الرواية: ص25.
[24] الرواية: ص157.
[25] القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، 2010، ط1، ص34،36.
[26] القصراوي، مها، الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ط1، ص37.
[27] لحمداني، حميد، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1991، ط1، ص73.
[28] بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ط1، ص156.
[29] لحمداني، حميد، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1991، ط1، ص77.
[30] الرواية: ص39.
[31] الرواية: ص83.
[32] يوسف، آمنة، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ط2، ص103-104.
[33] الرواية: 82.
[34] الحازمي، حسن، البناء الفني في الرواية، دار النابغة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ط1، ص389.
[35] الرواية: 154.
[36] القصراوي، مها، الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ط1، ص192.
[37] بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ط1، ص145.
[38] المرجع السابق نفسه، ص146.
[39] الرواية: ص93.
[40] الرواية: ص169.
[41] قاسم، سيزا، بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، عمان، 2004، ط1، ص95.
[42] فضل، صلاح، أساليب السرد في الرواية العربية، دار المدى للثقافة والنشر، 2003، ط1، ص18. (بتصرف)
[43] الرواية: ص43.
[44] الرواية: ص155.
[45] النعيمي، أحمد، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص37.
[46] بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ط1، ص132.
[47] الرواية: ص89.
[48] لحمداني، حميد، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1991، ط1، ص76.
[49] بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990، ط1، ص176-177.
[50] الرواية: ص15.
[51] الرواية: ص114-115.