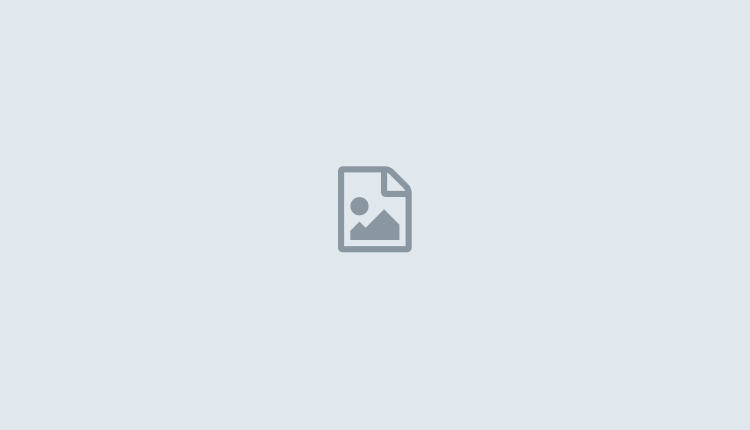جدتي مليحة
جدتي مليحة
د. مراد الكلالدة
هذه خاطرة لطالما رغبت أن أرويها عن جَدتي مليحة، وأظنها ستأذن لي بأن اخاطبها بإسمها الأول لأنها كانت مليحة معي ومع من معي، إنها جدتي لأمي “أم جميل” زوجة المرحوم عطا الله البدور.
لقد كانت بيضاء البشرة وبعيون عسلية، مدققة لها وشم على الذقن واليدين، وكانت تغطي رأسها بالعصابة وهي حجاب مكون من ثلاثة أجزاء، الأول منديل أبيض (ويستبدل بالأسود عند الأحزان) يغطي منتصف الرأس العلوي ويُشد من أعلى الجبين إلى مؤخرة الرأس، والثاني قماش ناعم أسود يوضع بشكل عرضي فوق القماش الأبيض تاركا متسع لبعض البياض ويلتف أسفل الذقن ويربط بشكالة سوداء مع الشعر من الجهة المقابلة، أما العصابة فهي سوداء أشبه بالعقال تغطس في الرأس لتجميع القماشين الأبيض والأسود. وقد إختلفت العصابة من منطقة لأخرى، فقد كانت عصابة الجنوبيات سوداء كما وصفت، وعصابة السلطيات ذات لون أحمر مطرّز بالخيوط الذهبية. أما ثوبها فهو أسود (مدرقة) مع جُبّة خضراء من الصوف تلبس أيام البرد.
لقد تزوجت صغيرة في عمر الرابعة عشر، وكان زواجها في العشرينات من القرن المنصرم، وكانت زوجة لا ثانية لها، وهذا نادر في مجتمع ريفي كالطفيلة، فقد عُرف عن الرجال حبهم للمَثنى والثلاث والرُباع، فأمّا جَدتي فقد كانت الأولى وظلت الأولى. كان زوجها شيخ بكل معنى الكلمة، فقد كان متعلماً يجيد القراءة والكتابة في زمن كانت فيه نسبة الأمية في الإمارة تتجاوز 98% مما جعله يحظى هو وسمّور القرعان بوظيفة جابي لدى وزارة المالية، حيث كانت الضرائب المصدر الوحيد للدولة الناشئة وكانت تدفع عن الأراضي المروية وعن المواشي. وكانت الوظيفة تدر عليه دخلاً منتظماً بالإضافة إلى المزارع في السيل وبطاح والغوير والثمد وسدير اللعبان وغيرها.
قليلة هي الدقائق التي كانت تجلس بها في بيتها بالطفيلة، فقد كانت كثيرة الحركة متنقلة بين حوش الدار والإسطبل والطابون والحظيرة. لقد كان مجالها الأرضي هذه المناطق الأربعة والتي يربطها ممر مكشوف يفضي إلى الشارع المؤدي إلى القلعة في حارة الكلالدة والتي تتفرع الى حمايل (المحيسن، الخلفات، العدينات، الزحيمات، الحميدات، البدور، الخمايسة) . لقد كان لأم جميل حضور مميز يستند لشخصيتها الرزينة وكلامها القليل وهيبة سَبيلها، وسأخبركم لاحقاً ما هو السبيل.
الدار، مكونة من عدة غرف ترتفع أثنتين عن الحوش عشرة درجات أو أكثر، وكانت تُستخدم هذه الغرف للمعيشة والنوم. غرفة الضيوف أو الديوان كانت مستقلة عن الغرف العلوية وكانت مطروقة من الحوش الى يسار المدخل الرئيسي ذو الباب الخشبي المُعشّق. أما المطبخ والحمام فقد كانت تقع في المساحة بين الكتلتين ومطروقة من الحوش أو كما كانت تسمى في بلاد الشام، بيت الدّيار أو الساحة السماوية. واجهات الدار كانت من الحجر الأصفر وكانت تعج بالأولاد والأحفاد والزوار، وعلى ذكر الزوار، كنت أسمع جدتي تتمتم شاكية من كثرة الولائم التي تجهد البلا وتهد الحيل.
تحضير الخبز على البكيّر حكاية بحد ذاتها، وقد كانت تضع الطحين والخميرة في الصحن المعدني الكبير وكنت أحظى بشرف سكب الماء الفاتر على يديها أثناء العجين ومن ثم تقوم بلفه بالبطانية ليختمر لساعة فينتفخ، تستغلها لإشعال النار في الطابون الذي يقع بالقرب من الإسطبل. إن الإقتراب من الطابون محرّم، وقد كنت استغرب وجود تجاويف في رغيف الطابون ونجحت مرة في إستراق النظر فشاهدت حجارة ملساء في قاع الطابون وعرفت بأنها هي التي تكون شكل الرغيف. آه ما أشهى اللقمة الأولى وما أطيب الثانية وما ألذ الثالثة ساخنة من الطابون.
ولا تكتمل السفرة بالخبز، فالحظيرة فيها الحلال لزوم الحليب واللحم، وفيها الدجاج البلدي وقد كانت جدتي تخرج من الحوش الى الممر لتصل الى الحظيرة في الطرف الثاني من شارع القلعة الذي يقع عليه منزل مصطفى باشا المحيسين. كانت تحمل سلة معدنية مشبكة فيها شيء من القش، وتخرج بها ممتلئة بالبيض البلدي بني اللون، وقد تركتني جدتي اراقبها تجمع البيض من الخم لا بل سمحت لي بإلتقاط واحدة ووضعها في السلة. صدقوني بأني استطيع وصف الخم بكل بتفاصيله لو أردت على الرغم من أني كنت صغيراً بعمر خمس سنوات. ديك الحبش بالعرف الأحمر كان يحوم خارج الحظيرة، وكنا نستفزه ونركض هاربين.
كان جَدي يلبس الثوب الأبيض والحطة البيضاء وعقال مرعز أسود وكانت العباءة أقرب إلى البياض (سكري) مقصّبة بخيوط ذهبية. وقد تطلب الظهور بهذه الهيئة الكثير من الجهد المنزلي من غسيل على اليد طبعاً والكوي على اللحاف بمكواة الحديد.
كان جدّي يخرج بعد الفطور من باب الدار منعطفاً يساراً نحو الإسطبل ليخرج فرسه البيضاء التي لا زال رسمها في مخيلتي كأنه اليوم، خيل عربي شامخة تهز رأسها إلى الأعلى إن حاول أحد غير جدّي الإقتراب منها، وصَدق العرب حين قالوا الخيل والمرأة لا تُستعار. يوم جدتي لا ينتهي بخروج زوجها ولكنها كانت تأخذ قسطاً من الراحة حين تستقبل بعض نساء الحي لتشعل سبيلها. والسبيل لمن لم يعرف حياة الأرياف، هو الغليون ولكنة كان غريب الشكل طويل القصبة، وقد كان محرماً على الجميع الإقتراب منه فهو مملكتها ومزاجها الذي استحقته بعد عناء يوم شاق. كانت تجلس على الفرشة وتسند ظهرها الى الحائط وتضع السبيل على الأرض وتشعل التمباك بقداحة فضية اللون حيرتني. وقد راقبتها وقد عرفت لاحقاً بأنها تعمل على البنزين أو الكاز لا أدري وذلك بترطيب قطعة قماش توضع بحجرة بداخلها. وما أن تنتنهي الظهرية، يبدأ التحضير للغذاء فنذهب إلى نبع “الجهير” لإحضار الماء وترافقنا جدتي أحياناً، وهذه رحلة عذاب يصعب وصفها في هذه العجالة. ولكي يجهز العشاء تراها تكثر من التنقل بين الأماكن تتمتم بالشكوى من حين لآخر. وعلى الرغم من أنها أنجبت ستة بنات فقد كانت لا تطلب مساعدتهن وكنَّ غالباً متزوجات ويحضرن ضيفات معززات مكرمات في بيت أهليهن. لن أتحدث عن معاناة جدتي مع أبنائها الذين خاضوا غمار السياسة في خمسينيات القرن الماضي لأني سأظلم جميع الأطراف لقدر تقصيري المتوقع في وصف حال الأم البسيطة التي كانت تلاحق أخبارهم في فلسطين ومصر وسوريا والعراق وألمانيا، أنهم من الرعيل الأول الذي لا أسمح لنفسي أن أخطيء بحرف عند الحديث عن نضالاتهم التي مكنتنا نحن الأردنيين من أن نتنفس بعض نسمات الحرية.
بعد وفاة زوجها أبو جميل 21 حزيران 1966 وموت فرسه التي لم تستطيع العيش بعده لأيام لأنها رفضت أن تأكل من غيره، وزواج البنات وإستقرار الأولاد بعمّان، تحايل عليها كبيرنا الدكتور جميل البدور وأسكنها بجناح في منزله، ولا زلت أذكر كم كان يجهد في البحث لها عن هدية تليق بها، فقد كانت قنوعة لدرجة الزُهد، وأكثر ما كان يسعدها هو سبيلها الطويل الذي استبدلته بعد عناد بغليون إنجليزي يليق بفمها الذي كانت تناديني به قائلة: تعال أحبك يا بنيّ، وبلغة أهل المِدن هذا يعني: تعال أبوسَك. غادرتنا جدتي مليحة وظلت قبلتها المليحة محفورة على خدي.